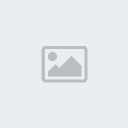تفسير سورة الكهف عدد آياتها 110 ( آية 1-27 ) وهي مكية
صفحة 1 من اصل 1
 تفسير سورة الكهف عدد آياتها 110 ( آية 1-27 ) وهي مكية
تفسير سورة الكهف عدد آياتها 110 ( آية 1-27 ) وهي مكية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا * قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا *مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا * فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا }
الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته، التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، وأجل نعمه على الإطلاق، إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم فحمد نفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليهم، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين، على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه، وإثبات أنه قيم مستقيم، فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، وإثبات الاستقامة، يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات وهي الأخبار، التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه، تزكي النفوس، وتطهرها وتنميها وتكملها، لاشتمالها على كمال العدل والقسط، والإخلاص، والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف. بما ذكر، أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به.
وقوله { لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ } أي: لينذر بهذا القرآن الكريم، عقابه الذي عنده، أي: قدره وقضاه، على من خالف أمره، وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة، وهذا أيضا، من نعمه أن خوف عباده، وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم.
كما قال تعالى -لما ذكر في هذا القرآن وصف النار- قال: { ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون } فمن رحمته بعباده، أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره، وبينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها.
{ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا } أي: وأنزل الله على عبده الكتاب، ليبشر المؤمنين به، وبرسله وكتبه، الذين كمل إيمانهم، فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي: الأعمال الصالحة، من واجب ومستحب، التي جمعت الإخلاص والمتابعة، { أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا } وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله، الفوز برضا الله ودخول الجنة، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن، دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما.
ومع ذلك فهذا الأجر الحسن { مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا } لا يزول عنهم، ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد، وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح، موصل لما تستبشر به النفوس، وتفرح به الأرواح.
{ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا } من اليهود والنصارى، والمشركين، الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة، فإنهم لم يقولوها عن علم و[لا] يقين، لا علم منهم، ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم، بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } أي: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه، ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية، والكذب عليه؟" { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا } ولهذا قال هنا: { إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا } أي: كذبا محضا ما فيه من الصدق شيء، وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج، والانتقال من شيء إلى أبطل منه، فأخبر أولا: أنه { مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ } والقول على الله بلا علم، لا شك في منعه وبطلانه، ثم أخبر ثانيا، أنه قول قبيح شنيع فقال: { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح، وهو: الكذب المنافي للصدق.
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين، ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم، ورحمة بهم، أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء، الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في الآية الأخرى: { لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين } وقال { فلا تذهب نفسك عليهم حسرات } وهنا قال { فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ } أي: مهلكها، غما وأسفا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار، فلذلك خذلهم، فلم يهتدوا، فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم، ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله، عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية، وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس، هادم للقوى، ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك، فهو خارج عن قدرته، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: { إنك لا تهدي من أحببت } وموسى عليه السلام يقول: { رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي } الآية، فمن عداهم من باب أولى وأحرى، قال تعالى: { فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر }
{ 7-8 } { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا }
يخبر تعالى: أنه جعل جميع ما على وجه الأرض، من مآكل لذيذة، ومشارب، ومساكن طيبة، وأشجار، وأنهار، وزروع، وثمار، ومناظر بهيجة، ورياض أنيقة، وأصوات شجية، وصور مليحة، وذهب وفضة، وخيل وإبل ونحوها، الجميع جعله الله زينة لهذه الدار، فتنة واختبارا. { لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } أي: أخلصه وأصوبه، ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات، فانية مضمحلة، وزائلة منقضية.
وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها، وانقطعت أنهارها، واندرست أثارها، وزال نعيمها، هذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها، ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا، فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها، من نظر إلى ظاهر الدنيا، دون باطنها، فصحبوا الدنيا صحبة البهائم، وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم، ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات، من أي وجه حصلت، وعلى أي حالة اتفقت، فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت، قلق لخراب ذاته، وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات.
وأما من نظر إلى باطن الدنيا، وعلم المقصود منها ومنه، فإنه يتناول منها، ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور، لا محل حبور، وشقة سفر، لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه، وتنفيذ أوامره، وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم، وسرور وتكريم، فنظر إلى باطن الدنيا، حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته، حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين، وما أبعد الفرق بين الطائفتين"
{ 9-12 } { أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا * إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا * فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا }
وهذا الاستفهام بمعنى النفي، والنهي. أي: لا تظن أن قصة أصحاب الكهف، وما جرى لهم، غريبة على آيات الله، وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها، ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير، من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها، فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم، ما يتبين به الحق من الباطل، والهدى من الضلال، وليس المراد بهذا النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإنما المراد، أن جنسها كثير جدا، فالوقوف معها وحدها، في مقام العجب والاستغراب، نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله، التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها، فإنها مفتاح الإيمان، وطريق العلم والإيقان. وأضافهم إلى الكهف، الذي هو الغار في الجبل، الرقيم، أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم، لملازمتهم له دهرا طويلا.
ثم ذكر قصتهم مجملة، وفصلها بعد ذلك فقال: { إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ } أي: الشباب، { إِلَى الْكَهْفِ } يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم، { فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً } أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر، وتوفقنا للخير { وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } أي: يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا، فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة، إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم، وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم، وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم، قال: { فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ } أي أنمناهم { سِنِينَ عَدَدًا } وهي ثلاث مائة سنة وتسع سنين، وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم وليكون آية بينة.
{ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ } أي: من نومهم { لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا } أي: لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم، كما قال تعالى: { وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ } الآية، وفي العلم بمقدار لبثهم، ضبط للحساب، ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، فلو استمروا على نومهم، لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم.
{ 13-14 } { نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا }
هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدق، الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه، { إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ } وهذا من جموع القلة، يدل ذلك على أنهم دون العشرة، { آمَنُوا } بالله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم، فزادهم هدى، أي: بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان، زادهم الله من الهدى، الذي هو العلم النافع، والعمل الصالح، كما قال تعالى: { ويزيد الله الذين اهتدوا هدى }
{ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ } أي صبرناهم وثبتناهم، وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبره، أن وفقهم للإيمان والهدى، والصبر والثبات، والطمأنينة.
{ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } أي: الذي خلقنا ورزقنا، ودبرنا وربانا، هو خالق السماوات والأرض، المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام، التي لا تخلق ولا ترزق، ولا تملك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهذا قالوا: { لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا } أي: من سائر المخلوقات { لَقَدْ قُلْنَا إِذًا } أي: إن دعونا معه آلهة، بعد ما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة، إلا له { شَطَطًا } أي: ميلا عظيما عن الحق، وطريقا بعيدة عن الصواب، فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والتزام ذلك، وبيان أنه الحق وما سواه باطل، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم، وزيادة الهدى من الله لهم.
{ 15 } { هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا }
لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى، والتفتوا إلى ما كان عليه قومهم، من اتخاذ الآلهة من دون الله، فمقتوهم، وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل في غاية الجهل والضلال فقالوا: { لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ } أي: بحجة وبرهان، على ما هم عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم، ولهذا قال: { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا }
{ 16 } { وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا }
أي: قال بعضهم لبعض، إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم، فلم يبق إلا النجاء من شرهم، والتسبب بالأسباب المفضية لذلك، لأنهم لا سبيل لهم إلى قتالهم، ولا بقائهم بين أظهرهم، وهم على غير دينهم، { فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ } أي: انضموا إليه واختفوا فيه { يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا } وفيما تقدم، أخبر أنهم دعوه بقولهم { ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا } فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم، والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم، ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك، لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته، وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ أديانهم وأبدانهم، وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن، ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب، حتى المحل الذي ناموا فيه، كان على غاية ما يمكن من الصيانة، ولهذا قال:
{ 17-18 } { وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا * وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا }
أي: حفظهم الله من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا، وعند غروبها تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها، { وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ } أي: من الكهف أي: مكان متسع، وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم، ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق، خصوصا مع طول المكث، وذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته بهم، وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور، ولهذا قال: { مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ } أي: لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين، { وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا } أي: لا تجد من يتولاه ويدبره، على ما فيه صلاحه، ولا يرشده إلى الخير والفلاح، لأن الله قد حكم عليه بالضلال، ولا راد لحكمه.
{ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ } أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم [كأنهم] أيقاظ، والحال أنهم نيام، قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة، لئلا تفسد، فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا، وهم رقود، { وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ } وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها، أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله، أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا، بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض، من غير تقليب، ولكنه تعالى حكيم، أراد أن تجري سنته في الكون، ويربط الأسباب بمسبباتها.
{ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ } أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته، فكان باسطا ذراعيه بالوصيد، أي: الباب، أو فنائه، هذا حفظهم من الأرض. وأما حفظهم من الآدميين، فأخبر أنه حماهم بالرعب، الذي نشره الله عليهم، فلو اطلع عليهم أحد، لامتلأ قلبه رعبا، وولى منهم فرارا، وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة، وهم لم يعثر عليهم أحد، مع قربهم من المدينة جدا، والدليل على قربهم، أنهم لما استيقظوا، أرسلوا أحدهم، يشتري لهم طعاما من المدينة، وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربهم منها.
{ 19-20 } { وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا * إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا }
يقول تعالى: { وكذلك بعثناهم } أي: من نومهم الطويل { ليتساءلوا بينهم } أي: ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم.
{ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ } وهذا مبني على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه. في طول مدتهم، فلهذا { قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ } فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء، جملة وتفصيلا، ولعل الله تعالى -بعد ذلك- أطلعهم على مدة لبثهم، لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا، وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم، الاشتباه، فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا، علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثا. ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها، وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك، وبما ذكر فيما بعده من قوله. { وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا } فلولا أنه حصل العلم بحالهم، لم يكونوا دليلا على ما ذكر، ثم إنهم لما تساءلوا بينهم، وجرى منهم ما أخبر الله به، أرسلوا أحدهم بورقهم، أي: بالدراهم، التي كانت معهم، ليشتري لهم طعاما يأكلونه، من المدينة التي خرجوا منها، وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه، أي: أطيبه وألذه، وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك، ويخفي حال إخوانه، ولا يشعرن بهم أحدا. وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم، وظهورهم عليهم، أنهم بين أمرين، إما الرجم بالحجارة، فيقتلونهم أشنع قتلة، لحنقهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتنوهم عن دينهم، ويردوهم في ملتم، وفي هذه الحال، لا يفلحون أبدا، بل يحشرون في دينهم ودنياهم وأخراهم، وقد دلت هاتان الآيتان، على عدة فوائد.
منها: الحث على العلم، وعلى المباحثة فيه، لكون الله بعثهم لأجل ذلك.
ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم، أن يرده إلى عالمه، وأن يقف عند حده.
ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء، وصحة الشركة في ذلك.
ومنها: جواز أكل الطيبات، والمطاعم اللذيذة، إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله { فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ } وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين، القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة، التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها.
ومنها: الحث على التحرز، والاستخفاء، والبعد عن مواقع الفتن في الدين، واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين.
ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين، وفرارهم من كل فتنة، في دينهم وتركهم أوطانهم في الله.
ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد، الداعية لبغضه، وتركه، وأن هذه الطريقة، هي طريقة المؤمنين المتقدمين، والمتأخرين لقولهم: { وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا }
{ 21 } { وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا }
يخبر الله تعالى، أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف، وذلك -والله أعلم- بعدما استيقظوا، وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما، وأمروه بالاستخفاء والإخفاء، فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس، وزيادة أجر لهم، وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله، المشاهدة بالعيان، على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد، بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فمن مثبت للوعد والجزاء، ومن ناف لذلك، فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين، وحجة على الجاحدين، وصار لهم أجر هذه القضية، وشهر الله أمرهم، ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم.
و { فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا } الله أعلم بحالهم ومآلهم، وقال من غلب على أمرهم، وهم الذين لهم الأمر:
{ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا } أي: نعبد الله تعالى فيه، ونتذكر به أحوالهم، وما جرى لهم، وهذه الحالة محظورة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدا، بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم، وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى.
وفي هذه القصة، دليل على أن من فر بدينه من الفتن، سلمه الله منها. وأن من حرص على العافية عافاه الله ومن أوى إلى الله، آواه الله، وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته، كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب { وما عند الله خير للأبرار }
{ 22 } { سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا }
يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف، اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب، وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال:
منهم: من يقول: ثلاثة، رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول: خمسة، سادسهم كلبهم. وهذان القولان، ذكر الله بعدهما، أن هذا رجم منهم بالغيب، فدل على بطلانهما.
ومنهم من يقول: سبعة، وثامنهم كلبهم، وهذا -والله أعلم- الصواب، لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله، فدل على صحته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس، دينية ولا دنيوية، ولهذا قال تعالى:
{ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ } وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. { فَلَا تُمَارِ } أي: تجادل وتحاج { فيهم إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا } أي: مبنيا على العلم واليقين، ويكون أيضا فيه فائدة، وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب، أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معاندا، أو تكون المسألة لا أهمية فيها، ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها، كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة المناقشات فيها، والبحوث المتسلسلة، تضييعا للزمان، وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة.
{ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ } أي: في شأن أهل الكهف { مِنْهُمْ } أي: من أهل الكتاب { أَحَدًا } وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن، الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يحجزه، وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه هو عن الفتوى، من باب أولى وأحرى.
وفي الآية أيضا، دليل على أن الشخص، قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء، دون آخر. فيستفتى فيما هو أهل له، بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف، وما أشبهها.
{ 23-24 } { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا }
هذا النهي كغيره، وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول صل الله عليه وسلم، فإن الخطاب عام للمكلفين، فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة، { إني فاعل ذلك } من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو: الكلام على الغيب المستقبل، الذي لا يدري، هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله { وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين } ولما في ذكر مشيئة الله، من تيسير الأمر وتسهيله، وحصول البركة فيه، والاستعانة من العبد لربه، ولما كان العبد بشرا، لا بد أن يسهو فيترك ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثني بعد ذلك، إذا ذكر، ليحصل المطلوب، وينفع المحذور، ويؤخذ من عموم قوله: { وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ } الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سها عنه، وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله، أن يذكر ربه، ولا يكونن من الغافلين، ولما كان العبد مفتقرا إلى الله في توفيقه للإصابة، وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله، أمره الله أن يقول: { عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا } فأمره أن يدعو الله ويرجوه، ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد. وحري بعبد، تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده، ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد، أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربه، وأن يسدده في جميع أموره.
{ 25-26 } { وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا * قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا }
لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب، في شأن أهل الكهف، لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة، العالم بكل شيء، أخبره بمدة لبثهم، وأن علم ذلك عنده وحده، فإنه من غيب السماوات والأرض، وغيبها مختص به، فما أخبر به عنها على ألسنة رسله، فهو الحق اليقين، الذي لا يشك فيه، وما لا يطلع رسله عليه، فإن أحدا من الخلق، لا يعلمه.
وقوله: { أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ } تعجب من كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات، بعد ما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات. ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة، فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون، الولي لعباده المؤمنين، يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرى، ويجنبهم العسرى، ولهذا قال: { مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ } أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف، بلطفه وكرمه، ولم يكلهم إلى أحد من الخلق.
{ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا } وهذا يشمل الحكم الكوني القدري، والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه، قضاء وقدرا، وخلقا وتدبيرا، والحاكم فيهم، بأمره ونهيه، وثوابه وعقابه.
ولما أخبر أنه تعالى، له غيب السماوات والأرض، فليس لمخلوق إليها طريق، إلا عن الطريق التي يخبر بها عباده، وكان هذا القرآن، قد اشتمل على كثير من الغيوب، أمر تعالى بالإقبال عليه فقال:
{ 27 } { وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا }
التلاوة: هي الاتباع، أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها، وتصديق أخباره، وامتثال أوامره ونواهيه، فإنه الكتاب الجليل، الذي لا مبدل لكلماته، أي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها، وبلوغها من الحسن فوق كل غاية { وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا } فلتمامها، استحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصة، لعرض لها ذلك أو شيء منه، وفي هذا تعظيم للقرآن، في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه.
{ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا } أي: لن تجد من دون ربك، ملجأ تلجأ إليه، ولا معاذا تعوذ به، فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه، في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسئول في جميع المطالب.
الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته، التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، وأجل نعمه على الإطلاق، إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم فحمد نفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم، وإنزال الكتاب عليهم، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين، على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه، وإثبات أنه قيم مستقيم، فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، وإثبات الاستقامة، يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات وهي الأخبار، التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه، تزكي النفوس، وتطهرها وتنميها وتكملها، لاشتمالها على كمال العدل والقسط، والإخلاص، والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. وحقيق بكتاب موصوف. بما ذكر، أن يحمد الله نفسه على إنزاله، وأن يتمدح إلى عباده به.
وقوله { لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ } أي: لينذر بهذا القرآن الكريم، عقابه الذي عنده، أي: قدره وقضاه، على من خالف أمره، وهذا يشمل عقاب الدنيا وعقاب الآخرة، وهذا أيضا، من نعمه أن خوف عباده، وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم.
كما قال تعالى -لما ذكر في هذا القرآن وصف النار- قال: { ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون } فمن رحمته بعباده، أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره، وبينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها.
{ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا } أي: وأنزل الله على عبده الكتاب، ليبشر المؤمنين به، وبرسله وكتبه، الذين كمل إيمانهم، فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي: الأعمال الصالحة، من واجب ومستحب، التي جمعت الإخلاص والمتابعة، { أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا } وهو الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظمه وأجله، الفوز برضا الله ودخول الجنة، التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن، دلالة على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسنه تاما.
ومع ذلك فهذا الأجر الحسن { مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا } لا يزول عنهم، ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد، وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، وهو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح، موصل لما تستبشر به النفوس، وتفرح به الأرواح.
{ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا } من اليهود والنصارى، والمشركين، الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة، فإنهم لم يقولوها عن علم و[لا] يقين، لا علم منهم، ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم، بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } أي: عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، وأي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه، ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية، والكذب عليه؟" { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا } ولهذا قال هنا: { إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا } أي: كذبا محضا ما فيه من الصدق شيء، وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج، والانتقال من شيء إلى أبطل منه، فأخبر أولا: أنه { مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ } والقول على الله بلا علم، لا شك في منعه وبطلانه، ثم أخبر ثانيا، أنه قول قبيح شنيع فقال: { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ } ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح، وهو: الكذب المنافي للصدق.
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين، ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين، شفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم، ورحمة بهم، أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء، الذين لا يؤمنون بهذا القرآن، كما قال في الآية الأخرى: { لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين } وقال { فلا تذهب نفسك عليهم حسرات } وهنا قال { فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ } أي: مهلكها، غما وأسفا عليهم، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار، فلذلك خذلهم، فلم يهتدوا، فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم، ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية ونحوها عبرة، فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله، عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية، وسد طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنه، مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس، هادم للقوى، ليس فيه فائدة، بل يمضي على فعله الذي كلف به وتوجه إليه، وما عدا ذلك، فهو خارج عن قدرته، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: { إنك لا تهدي من أحببت } وموسى عليه السلام يقول: { رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي } الآية، فمن عداهم من باب أولى وأحرى، قال تعالى: { فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر }
{ 7-8 } { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا }
يخبر تعالى: أنه جعل جميع ما على وجه الأرض، من مآكل لذيذة، ومشارب، ومساكن طيبة، وأشجار، وأنهار، وزروع، وثمار، ومناظر بهيجة، ورياض أنيقة، وأصوات شجية، وصور مليحة، وذهب وفضة، وخيل وإبل ونحوها، الجميع جعله الله زينة لهذه الدار، فتنة واختبارا. { لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } أي: أخلصه وأصوبه، ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات، فانية مضمحلة، وزائلة منقضية.
وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها، وانقطعت أنهارها، واندرست أثارها، وزال نعيمها، هذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها، ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا، فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها، من نظر إلى ظاهر الدنيا، دون باطنها، فصحبوا الدنيا صحبة البهائم، وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم، ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات، من أي وجه حصلت، وعلى أي حالة اتفقت، فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت، قلق لخراب ذاته، وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات.
وأما من نظر إلى باطن الدنيا، وعلم المقصود منها ومنه، فإنه يتناول منها، ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور، لا محل حبور، وشقة سفر، لا منزل إقامة، فبذل جهده في معرفة ربه، وتنفيذ أوامره، وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم، وسرور وتكريم، فنظر إلى باطن الدنيا، حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته، حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين، وما أبعد الفرق بين الطائفتين"
{ 9-12 } { أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا * إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا * فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا }
وهذا الاستفهام بمعنى النفي، والنهي. أي: لا تظن أن قصة أصحاب الكهف، وما جرى لهم، غريبة على آيات الله، وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها، ولا مجانس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير، من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها، فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم، ما يتبين به الحق من الباطل، والهدى من الضلال، وليس المراد بهذا النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإنما المراد، أن جنسها كثير جدا، فالوقوف معها وحدها، في مقام العجب والاستغراب، نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله، التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها، فإنها مفتاح الإيمان، وطريق العلم والإيقان. وأضافهم إلى الكهف، الذي هو الغار في الجبل، الرقيم، أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم، لملازمتهم له دهرا طويلا.
ثم ذكر قصتهم مجملة، وفصلها بعد ذلك فقال: { إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ } أي: الشباب، { إِلَى الْكَهْفِ } يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم، { فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً } أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر، وتوفقنا للخير { وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا } أي: يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا، فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة، إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم، وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم، وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم، قال: { فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ } أي أنمناهم { سِنِينَ عَدَدًا } وهي ثلاث مائة سنة وتسع سنين، وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم وليكون آية بينة.
{ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ } أي: من نومهم { لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا } أي: لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم، كما قال تعالى: { وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ } الآية، وفي العلم بمقدار لبثهم، ضبط للحساب، ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، فلو استمروا على نومهم، لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم.
{ 13-14 } { نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا }
هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدق، الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه، { إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ } وهذا من جموع القلة، يدل ذلك على أنهم دون العشرة، { آمَنُوا } بالله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم، فزادهم هدى، أي: بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان، زادهم الله من الهدى، الذي هو العلم النافع، والعمل الصالح، كما قال تعالى: { ويزيد الله الذين اهتدوا هدى }
{ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ } أي صبرناهم وثبتناهم، وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبره، أن وفقهم للإيمان والهدى، والصبر والثبات، والطمأنينة.
{ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } أي: الذي خلقنا ورزقنا، ودبرنا وربانا، هو خالق السماوات والأرض، المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام، التي لا تخلق ولا ترزق، ولا تملك نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولهذا قالوا: { لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا } أي: من سائر المخلوقات { لَقَدْ قُلْنَا إِذًا } أي: إن دعونا معه آلهة، بعد ما علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة، إلا له { شَطَطًا } أي: ميلا عظيما عن الحق، وطريقا بعيدة عن الصواب، فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والتزام ذلك، وبيان أنه الحق وما سواه باطل، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم، وزيادة الهدى من الله لهم.
{ 15 } { هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا }
لما ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان والهدى، والتفتوا إلى ما كان عليه قومهم، من اتخاذ الآلهة من دون الله، فمقتوهم، وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم، بل في غاية الجهل والضلال فقالوا: { لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ } أي: بحجة وبرهان، على ما هم عليه من الباطل، ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، وإنما ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه، وهذا أعظم الظلم، ولهذا قال: { فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا }
{ 16 } { وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا }
أي: قال بعضهم لبعض، إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم، فلم يبق إلا النجاء من شرهم، والتسبب بالأسباب المفضية لذلك، لأنهم لا سبيل لهم إلى قتالهم، ولا بقائهم بين أظهرهم، وهم على غير دينهم، { فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ } أي: انضموا إليه واختفوا فيه { يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا } وفيما تقدم، أخبر أنهم دعوه بقولهم { ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا } فجمعوا بين التبري من حولهم وقوتهم، والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم، ودعائه بذلك، وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك، لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته، وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ أديانهم وأبدانهم، وجعلهم من آياته على خلقه، ونشر لهم من الثناء الحسن، ما هو من رحمته بهم، ويسر لهم كل سبب، حتى المحل الذي ناموا فيه، كان على غاية ما يمكن من الصيانة، ولهذا قال:
{ 17-18 } { وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا * وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا }
أي: حفظهم الله من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا، وعند غروبها تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها، { وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ } أي: من الكهف أي: مكان متسع، وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم، ويزول عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيق، خصوصا مع طول المكث، وذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته بهم، وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور، ولهذا قال: { مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ } أي: لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين، { وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا } أي: لا تجد من يتولاه ويدبره، على ما فيه صلاحه، ولا يرشده إلى الخير والفلاح، لأن الله قد حكم عليه بالضلال، ولا راد لحكمه.
{ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ } أي: تحسبهم أيها الناظر إليهم [كأنهم] أيقاظ، والحال أنهم نيام، قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة، لئلا تفسد، فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا، وهم رقود، { وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ } وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها، أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله، أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا، بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض، من غير تقليب، ولكنه تعالى حكيم، أراد أن تجري سنته في الكون، ويربط الأسباب بمسبباتها.
{ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ } أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته، فكان باسطا ذراعيه بالوصيد، أي: الباب، أو فنائه، هذا حفظهم من الأرض. وأما حفظهم من الآدميين، فأخبر أنه حماهم بالرعب، الذي نشره الله عليهم، فلو اطلع عليهم أحد، لامتلأ قلبه رعبا، وولى منهم فرارا، وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة، وهم لم يعثر عليهم أحد، مع قربهم من المدينة جدا، والدليل على قربهم، أنهم لما استيقظوا، أرسلوا أحدهم، يشتري لهم طعاما من المدينة، وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربهم منها.
{ 19-20 } { وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا * إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا }
يقول تعالى: { وكذلك بعثناهم } أي: من نومهم الطويل { ليتساءلوا بينهم } أي: ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم.
{ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ } وهذا مبني على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه. في طول مدتهم، فلهذا { قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ } فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء، جملة وتفصيلا، ولعل الله تعالى -بعد ذلك- أطلعهم على مدة لبثهم، لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا، وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر أمرهم، الاشتباه، فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا، علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثا. ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها، وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك، وبما ذكر فيما بعده من قوله. { وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا } فلولا أنه حصل العلم بحالهم، لم يكونوا دليلا على ما ذكر، ثم إنهم لما تساءلوا بينهم، وجرى منهم ما أخبر الله به، أرسلوا أحدهم بورقهم، أي: بالدراهم، التي كانت معهم، ليشتري لهم طعاما يأكلونه، من المدينة التي خرجوا منها، وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه، أي: أطيبه وألذه، وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك، ويخفي حال إخوانه، ولا يشعرن بهم أحدا. وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم، وظهورهم عليهم، أنهم بين أمرين، إما الرجم بالحجارة، فيقتلونهم أشنع قتلة، لحنقهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتنوهم عن دينهم، ويردوهم في ملتم، وفي هذه الحال، لا يفلحون أبدا، بل يحشرون في دينهم ودنياهم وأخراهم، وقد دلت هاتان الآيتان، على عدة فوائد.
منها: الحث على العلم، وعلى المباحثة فيه، لكون الله بعثهم لأجل ذلك.
ومنها: الأدب فيمن اشتبه عليه العلم، أن يرده إلى عالمه، وأن يقف عند حده.
ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء، وصحة الشركة في ذلك.
ومنها: جواز أكل الطيبات، والمطاعم اللذيذة، إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله { فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ } وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين، القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة، التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها.
ومنها: الحث على التحرز، والاستخفاء، والبعد عن مواقع الفتن في الدين، واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين.
ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين، وفرارهم من كل فتنة، في دينهم وتركهم أوطانهم في الله.
ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد، الداعية لبغضه، وتركه، وأن هذه الطريقة، هي طريقة المؤمنين المتقدمين، والمتأخرين لقولهم: { وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا }
{ 21 } { وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا }
يخبر الله تعالى، أنه أطلع الناس على حال أهل الكهف، وذلك -والله أعلم- بعدما استيقظوا، وبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاما، وأمروه بالاستخفاء والإخفاء، فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس، وزيادة أجر لهم، وهو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله، المشاهدة بالعيان، على أن وعد الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا بعد، بعدما كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فمن مثبت للوعد والجزاء، ومن ناف لذلك، فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين للمؤمنين، وحجة على الجاحدين، وصار لهم أجر هذه القضية، وشهر الله أمرهم، ورفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم.
و { فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا } الله أعلم بحالهم ومآلهم، وقال من غلب على أمرهم، وهم الذين لهم الأمر:
{ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا } أي: نعبد الله تعالى فيه، ونتذكر به أحوالهم، وما جرى لهم، وهذه الحالة محظورة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدا، بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم، وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى.
وفي هذه القصة، دليل على أن من فر بدينه من الفتن، سلمه الله منها. وأن من حرص على العافية عافاه الله ومن أوى إلى الله، آواه الله، وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته، كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب { وما عند الله خير للأبرار }
{ 22 } { سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا }
يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف، اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب، وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال:
منهم: من يقول: ثلاثة، رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول: خمسة، سادسهم كلبهم. وهذان القولان، ذكر الله بعدهما، أن هذا رجم منهم بالغيب، فدل على بطلانهما.
ومنهم من يقول: سبعة، وثامنهم كلبهم، وهذا -والله أعلم- الصواب، لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله، فدل على صحته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس، دينية ولا دنيوية، ولهذا قال تعالى:
{ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ } وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم. { فَلَا تُمَارِ } أي: تجادل وتحاج { فيهم إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا } أي: مبنيا على العلم واليقين، ويكون أيضا فيه فائدة، وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب، أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معاندا، أو تكون المسألة لا أهمية فيها، ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها، كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة المناقشات فيها، والبحوث المتسلسلة، تضييعا للزمان، وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة.
{ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ } أي: في شأن أهل الكهف { مِنْهُمْ } أي: من أهل الكتاب { أَحَدًا } وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن، الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به، وليس عنده ورع يحجزه، وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه هو عن الفتوى، من باب أولى وأحرى.
وفي الآية أيضا، دليل على أن الشخص، قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء، دون آخر. فيستفتى فيما هو أهل له، بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف، وما أشبهها.
{ 23-24 } { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا }
هذا النهي كغيره، وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول صل الله عليه وسلم، فإن الخطاب عام للمكلفين، فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة، { إني فاعل ذلك } من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو: الكلام على الغيب المستقبل، الذي لا يدري، هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله { وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين } ولما في ذكر مشيئة الله، من تيسير الأمر وتسهيله، وحصول البركة فيه، والاستعانة من العبد لربه، ولما كان العبد بشرا، لا بد أن يسهو فيترك ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثني بعد ذلك، إذا ذكر، ليحصل المطلوب، وينفع المحذور، ويؤخذ من عموم قوله: { وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ } الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سها عنه، وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله، أن يذكر ربه، ولا يكونن من الغافلين، ولما كان العبد مفتقرا إلى الله في توفيقه للإصابة، وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله، أمره الله أن يقول: { عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا } فأمره أن يدعو الله ويرجوه، ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد. وحري بعبد، تكون هذه حاله، ثم يبذل جهده، ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد، أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربه، وأن يسدده في جميع أموره.
{ 25-26 } { وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا * قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا }
لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب، في شأن أهل الكهف، لعدم علمهم بذلك، وكان الله عالم الغيب والشهادة، العالم بكل شيء، أخبره بمدة لبثهم، وأن علم ذلك عنده وحده، فإنه من غيب السماوات والأرض، وغيبها مختص به، فما أخبر به عنها على ألسنة رسله، فهو الحق اليقين، الذي لا يشك فيه، وما لا يطلع رسله عليه، فإن أحدا من الخلق، لا يعلمه.
وقوله: { أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ } تعجب من كمال سمعه وبصره، وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات، بعد ما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات. ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة والخاصة، فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون، الولي لعباده المؤمنين، يخرجهم من الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرى، ويجنبهم العسرى، ولهذا قال: { مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ } أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف، بلطفه وكرمه، ولم يكلهم إلى أحد من الخلق.
{ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا } وهذا يشمل الحكم الكوني القدري، والحكم الشرعي الديني، فإنه الحاكم في خلقه، قضاء وقدرا، وخلقا وتدبيرا، والحاكم فيهم، بأمره ونهيه، وثوابه وعقابه.
ولما أخبر أنه تعالى، له غيب السماوات والأرض، فليس لمخلوق إليها طريق، إلا عن الطريق التي يخبر بها عباده، وكان هذا القرآن، قد اشتمل على كثير من الغيوب، أمر تعالى بالإقبال عليه فقال:
{ 27 } { وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا }
التلاوة: هي الاتباع، أي: اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها، وتصديق أخباره، وامتثال أوامره ونواهيه، فإنه الكتاب الجليل، الذي لا مبدل لكلماته، أي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها، وبلوغها من الحسن فوق كل غاية { وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا } فلتمامها، استحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصة، لعرض لها ذلك أو شيء منه، وفي هذا تعظيم للقرآن، في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه.
{ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا } أي: لن تجد من دون ربك، ملجأ تلجأ إليه، ولا معاذا تعوذ به، فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه، في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسئول في جميع المطالب.
 مواضيع مماثلة
مواضيع مماثلة» تفسير سورة الكهف عدد آياتها 110 ( آية 83-110 ) وهي مكية
» تفسير سورة الكهف عدد آياتها 110 ( آية 28-50 ) وهي مكية
» - تفسير سورة الكهف عدد آياتها 110 ( آية 51-82 ) وهي مكية
» سورة الكهف - مكية - عدد آياتها 110
» تفسير سورة طه عدد آياتها 135 ( آية 1-36 ) وهي مكية
» تفسير سورة الكهف عدد آياتها 110 ( آية 28-50 ) وهي مكية
» - تفسير سورة الكهف عدد آياتها 110 ( آية 51-82 ) وهي مكية
» سورة الكهف - مكية - عدد آياتها 110
» تفسير سورة طه عدد آياتها 135 ( آية 1-36 ) وهي مكية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى