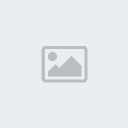- تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 51-75 ) وهي مدنية
صفحة 1 من اصل 1
 - تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 51-75 ) وهي مدنية
- تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 51-75 ) وهي مدنية
{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا * أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا * أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا * فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا }
وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث، حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله، والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله، أو حكم بغير شرع الله.
فدخل في ذلك السحر والكهانة، وعباده غير الله، وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت، وكذلك حَمَلهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله -عبدة الأصنام- على طريق المؤمنين فقال: { وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا } أي: لأجلهم تملقا لهم ومداهنة، وبغضا للإيمان: { هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا } أي: طريقا. فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم" كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟" هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء، أو يدخل عقلَ أحد من الجهلاء، فهل يُفَضَّل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان، واستقام على تحريم الطيبات، وإباحة الخبائث، وإحلال كثير من المحرمات، وإقامة الظلم بين الخلق، وتسوية الخالق بالمخلوقين، والكفر بالله ورسله وكتبه، على دين قام على عبادة الرحمن، والإخلاص لله في السر والإعلان، والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق، حتى البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس، وتحريم كل خبيث وظلم، والصدق في جميع الأقوال والأعمال، فهل هذا إلا من الهذيان، وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع، ولهذا قال تعالى عنهم: { أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ } أي: طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. { وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا } أي: يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان.
{ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ } أي: فيفضِّلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم، فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة، فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل، ولهذا قال: { فَإِذًا } أي: لو كان لهم نصيب من الملك { لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا } أي: شيئًا ولا قليلا. وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله. وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد.
{ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } أي: هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاءَ لله فيفضلون من شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسدُ للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله. { فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا } وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كـ "داود" و "سليمان" . فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده المؤمنين. فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له؟"
{ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ } أي: بمحمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي. { وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ } عنادًا وبغيًا وحسدًا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم { وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا } تسعر على من كفر بالله، وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة.
ولهذا قال: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا } أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة { كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ } أي: احترقت { بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ } أي: ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. وكما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم وسجية؛ كرر عليهم العذاب جزاء وِفاقا، ولهذا قال: { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا } أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره، وثوابه وعقابه.
{ وَالَّذِينَ آمَنُوا } أي: بالله وما أوجب الإيمانَ به { وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } من الواجبات والمستحبات { سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ } أي: من الأخلاق الرذيلة، والخلْق الذميم، ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب { وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا }
{ 58 - 59 } { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }
الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. فأمر الله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار؛ والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها. قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك.
وفي قوله: { إِلَى أَهْلِهَا } دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمِن، ووكيلُه بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها.
{ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر، والولي والعدو.
والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: { إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا } وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه، لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون.
ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما، الواجب والمستحب، واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس، من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية.
ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما.
فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال: { إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها { ذَلِكَ } أي: الرد إلى الله ورسوله { خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم.
{ 60 - 63 } { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا }
يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين. { الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ } مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا { يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ } وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت.
والحال أنهم { قد أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ } فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمَنْ زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك. وهذا من إضلال الشيطان إياهم، ولهذا قال: { وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا } عن الحق.
{ فَكَيْفَ } يكون حال هؤلاء الضالين { إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ } من المعاصي ومنها تحكيم الطاغوت؟!
{ ثُمَّ جَاءُوكَ } معتذرين لما صدر منهم، ويقولون: { إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا } أي: ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كَذَبة في ذلك. فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله { ومَنْ أحْسَن من الله حكمًا لقوْمٍ يوقنون }
ولهذا قال: { أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ } أي: من النفاق والقصد السيئ. { فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ } أي: لا تبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه. { وَعِظْهُمْ } أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله، والترهيب من تركه { وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا } أي: انصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود، وبالغ في زجرهم وقمعهم عمَّا كانوا عليه، وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرًا، ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به.
{ 64 - 65 } { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا * فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }
يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له. وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسلُ إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطيع للمطاع.
وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله، وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ، لما أمر بذلك مطلقا.
وقوله: { بِإِذْنِ اللَّهِ } أي: الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره. ففيه إثبات القضاء والقدر، والحث على الاستعانة بالله، وبيان أنه لا يمكن الإنسان -إن لم يعنه الله- أن يطيع الرسول.
ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده، ودعوته لمن اقترفوا السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله فقال: { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ } أي: معترفين بذنوبهم باخعين بها.
{ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا } أي: لتاب عليهم بمغفرته ظلْمَهم، ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها، وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك.
ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي: في كل شيء يحصل فيه اختلاف، بخلاف مسائل الإجماع، فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليمًا بانشراح صدر، وطمأنينة نفس، وانقياد بالظاهر والباطن.
فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمَن استكمل هذه المراتب وكملها، فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمَن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومَن تركه، مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين.
{ 66 - 68 } { وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا * وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا }
يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد، ولا يشق فعلها، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات، لتخف عليه العبادات، ويزداد حمدًا وشكرًا لربه.
ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به أي: ما وُظِّف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم، ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه، ولم يكونوا بصدده، وهذا هو الذي ينبغي للعبد، أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا، وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة، وحصول الكسل وعدم النشاط.
ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور:
(أحدها) الخيرية في قوله: { لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ } أي: لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده.
(الثاني) حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان، الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد. فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر. فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين، عند الموت وفي القبر.
وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به، لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات.
(الثالث) قوله: { وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا } أي: في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبُدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
(الرابع) الهداية إلى صراط مستقيم. وهذا عموم بعد خصوص، لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق، ومحبته وإيثاره والعمل به، وتوقف السعادة والفلاح على ذلك، فمن هُدِيَ إلى صراط مستقيم، فقد وُفِّقَ لكل خير واندفع عنه كل شر وضير.
{ 69 - 70 } { وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا * ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا }
أي: كل مَنْ أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، { فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ } أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة { مِنَ النَّبِيِّينَ } الذين فضلهم الله بوحيه، واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق، ودعوتهم إلى الله تعالى { وَالصِّدِّيقِينَ } وهم: الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل، فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم، وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، { وَالشُّهَدَاءِ } الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، { وَالصَّالِحِينَ } الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم { وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا } بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأُنْس بقربهم في جوار رب العالمين.
{ ذَلِكَ الْفَضْلُ } الذي نالوه { مِنَ اللَّهِ } فهو الذي وفقهم لذلك، وأعانهم عليه، وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم.
{ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا } يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل، بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح.
{ 71 - 74 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا * وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا * وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا * فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا }
يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين. وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب، التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم، من استعمال الحصون والخنادق، وتعلم الرمي والركوب، وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم، ومخارجهم، ومكرهم، والنفير في سبيل الله.
ولهذا قال: { فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ } أي: متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش، ويقيم غيرهم { أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا } وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية، والراحة للمسلمين في دينهم، وهذه الآية نظير قوله تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ }
ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: { وَإِنَّ مِنْكُمْ } أي: أيها المؤمنون { لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ } أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا، هذا الصحيح.
وقيل معناه: ليبطئن غيرَه أي: يزهده عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون، ولكن الأول أَولى لوجهين:
أحدهما: قوله { مِنْكُمْ } والخطاب للمؤمنين.
والثاني: قوله في آخر الآية: { كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ } فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين:
صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد.
وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد.
كما قال تعالى: { قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا } إلى آخر الآيات. ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال: { فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ } أي: هزيمة وقتل، وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم. { قَالَ } ذلك المتخلف { قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا } رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة. ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة، التي بها يقوى الإيمان، ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران، ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب.
وأما القعود فإنه وإن استراح قليلاً، فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة، ويفوته ما يحصل للمجاهدين.
ثم قال: { وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ } أي: نصر وغنيمة { لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا } أي: يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم، ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها ولو على يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين ويألمون بفقدها، ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم، فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط، ليست معه الروح الإيمانية المذكورة.
ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته، ولا يغلق عنهم أبوابها. بل من حصل منه غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه، فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله فقال: { فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ } هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها.
وقيل: إن معناه: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان، الصادقون في إيمانهم { الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ } أي: يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها.
فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطَّنوها على جهاد الأعداء، لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك.
وأما أولئك المتثاقلون، فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله تعالى: { قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا } إلى آخر الآيات. وقوله: { فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ } وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه "الذين" في محل نصب على المفعولية.
{ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله، ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله. { فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا } زيادة في إيمانه ودينه، وغنيمة، وثناء حسنا، وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
{ 75 } { وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا }
هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: { وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة.
ويدعون الله أن يجعل لهم وليًّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها، فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء.
وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث، حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله، والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله، أو حكم بغير شرع الله.
فدخل في ذلك السحر والكهانة، وعباده غير الله، وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت والطاغوت، وكذلك حَمَلهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله -عبدة الأصنام- على طريق المؤمنين فقال: { وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا } أي: لأجلهم تملقا لهم ومداهنة، وبغضا للإيمان: { هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا } أي: طريقا. فما أسمجهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم" كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟" هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء، أو يدخل عقلَ أحد من الجهلاء، فهل يُفَضَّل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان، واستقام على تحريم الطيبات، وإباحة الخبائث، وإحلال كثير من المحرمات، وإقامة الظلم بين الخلق، وتسوية الخالق بالمخلوقين، والكفر بالله ورسله وكتبه، على دين قام على عبادة الرحمن، والإخلاص لله في السر والإعلان، والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق، حتى البهائم، وإقامة العدل والقسط بين الناس، وتحريم كل خبيث وظلم، والصدق في جميع الأقوال والأعمال، فهل هذا إلا من الهذيان، وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا، وإما من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق، وهذا هو الواقع، ولهذا قال تعالى عنهم: { أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ } أي: طردهم عن رحمته وأحل عليهم نقمته. { وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا } أي: يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاره، وهذا غاية الخذلان.
{ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ } أي: فيفضِّلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد أهوائهم، فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة، فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل، ولهذا قال: { فَإِذًا } أي: لو كان لهم نصيب من الملك { لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا } أي: شيئًا ولا قليلا. وهذا وصف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله. وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد.
{ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } أي: هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاءَ لله فيفضلون من شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسدُ للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله. { فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا } وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كـ "داود" و "سليمان" . فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده المؤمنين. فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله وأخشاهم له؟"
{ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ } أي: بمحمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي. { وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ } عنادًا وبغيًا وحسدًا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم { وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا } تسعر على من كفر بالله، وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة.
ولهذا قال: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا } أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة { كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ } أي: احترقت { بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ } أي: ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. وكما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم وسجية؛ كرر عليهم العذاب جزاء وِفاقا، ولهذا قال: { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا } أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره، وثوابه وعقابه.
{ وَالَّذِينَ آمَنُوا } أي: بالله وما أوجب الإيمانَ به { وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } من الواجبات والمستحبات { سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ } أي: من الأخلاق الرذيلة، والخلْق الذميم، ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب { وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا }
{ 58 - 59 } { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }
الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. فأمر الله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار؛ والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها. قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك.
وفي قوله: { إِلَى أَهْلِهَا } دلالة على أنها لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمِن، ووكيلُه بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها.
{ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر، والولي والعدو.
والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: { إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا } وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه، لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون.
ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهما، الواجب والمستحب، واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس، من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية.
ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية، إما بصريحهما أو عمومهما؛ أو إيماء، أو تنبيه، أو مفهوم، أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه، لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين، ولا يستقيم الإيمان إلا بهما.
فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال: { إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت، كما ذكر في الآية بعدها { ذَلِكَ } أي: الرد إلى الله ورسوله { خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم.
{ 60 - 63 } { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا }
يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين. { الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ } مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا { يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ } وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت.
والحال أنهم { قد أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ } فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمَنْ زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله، فهو كاذب في ذلك. وهذا من إضلال الشيطان إياهم، ولهذا قال: { وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا } عن الحق.
{ فَكَيْفَ } يكون حال هؤلاء الضالين { إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ } من المعاصي ومنها تحكيم الطاغوت؟!
{ ثُمَّ جَاءُوكَ } معتذرين لما صدر منهم، ويقولون: { إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا } أي: ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كَذَبة في ذلك. فإن الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله { ومَنْ أحْسَن من الله حكمًا لقوْمٍ يوقنون }
ولهذا قال: { أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ } أي: من النفاق والقصد السيئ. { فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ } أي: لا تبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه. { وَعِظْهُمْ } أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله، والترهيب من تركه { وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا } أي: انصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود، وبالغ في زجرهم وقمعهم عمَّا كانوا عليه، وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرًا، ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به.
{ 64 - 65 } { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا * فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }
يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له. وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسلُ إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه، وأن يكونوا معظمين تعظيم المطيع للمطاع.
وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله، وفيما يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ، لما أمر بذلك مطلقا.
وقوله: { بِإِذْنِ اللَّهِ } أي: الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره. ففيه إثبات القضاء والقدر، والحث على الاستعانة بالله، وبيان أنه لا يمكن الإنسان -إن لم يعنه الله- أن يطيع الرسول.
ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده، ودعوته لمن اقترفوا السيئات أن يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله فقال: { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ } أي: معترفين بذنوبهم باخعين بها.
{ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا } أي: لتاب عليهم بمغفرته ظلْمَهم، ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لها والثواب عليها، وهذا المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك.
ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما شجر بينهم، أي: في كل شيء يحصل فيه اختلاف، بخلاف مسائل الإجماع، فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة، ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق، وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض، ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه تسليمًا بانشراح صدر، وطمأنينة نفس، وانقياد بالظاهر والباطن.
فالتحكيم في مقام الإسلام، وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمَن استكمل هذه المراتب وكملها، فقد استكمل مراتب الدين كلها. فمَن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومَن تركه، مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين.
{ 66 - 68 } { وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا * وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا * وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا }
يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد، ولا يشق فعلها، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات، لتخف عليه العبادات، ويزداد حمدًا وشكرًا لربه.
ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به أي: ما وُظِّف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم، ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه، ولم يكونوا بصدده، وهذا هو الذي ينبغي للعبد، أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا، وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة، وحصول الكسل وعدم النشاط.
ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور:
(أحدها) الخيرية في قوله: { لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ } أي: لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده.
(الثاني) حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان، الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد. فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر. فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين، عند الموت وفي القبر.
وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به، لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات.
(الثالث) قوله: { وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا } أي: في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبُدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
(الرابع) الهداية إلى صراط مستقيم. وهذا عموم بعد خصوص، لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق، ومحبته وإيثاره والعمل به، وتوقف السعادة والفلاح على ذلك، فمن هُدِيَ إلى صراط مستقيم، فقد وُفِّقَ لكل خير واندفع عنه كل شر وضير.
{ 69 - 70 } { وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا * ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا }
أي: كل مَنْ أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، { فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ } أي: النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة { مِنَ النَّبِيِّينَ } الذين فضلهم الله بوحيه، واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق، ودعوتهم إلى الله تعالى { وَالصِّدِّيقِينَ } وهم: الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل، فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم، وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، { وَالشُّهَدَاءِ } الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، { وَالصَّالِحِينَ } الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم { وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا } بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأُنْس بقربهم في جوار رب العالمين.
{ ذَلِكَ الْفَضْلُ } الذي نالوه { مِنَ اللَّهِ } فهو الذي وفقهم لذلك، وأعانهم عليه، وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم.
{ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا } يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل، بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح.
{ 71 - 74 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا * وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا * وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا * فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا }
يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين. وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب، التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم، من استعمال الحصون والخنادق، وتعلم الرمي والركوب، وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم، ومخارجهم، ومكرهم، والنفير في سبيل الله.
ولهذا قال: { فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ } أي: متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش، ويقيم غيرهم { أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا } وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية، والراحة للمسلمين في دينهم، وهذه الآية نظير قوله تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ }
ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: { وَإِنَّ مِنْكُمْ } أي: أيها المؤمنون { لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ } أي: يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا، هذا الصحيح.
وقيل معناه: ليبطئن غيرَه أي: يزهده عن القتال، وهؤلاء هم المنافقون، ولكن الأول أَولى لوجهين:
أحدهما: قوله { مِنْكُمْ } والخطاب للمؤمنين.
والثاني: قوله في آخر الآية: { كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ } فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين:
صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد.
وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد.
كما قال تعالى: { قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا } إلى آخر الآيات. ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال: { فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ } أي: هزيمة وقتل، وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لما لله في ذلك من الحكم. { قَالَ } ذلك المتخلف { قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا } رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة. ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة، التي بها يقوى الإيمان، ويسلم بها العبد من العقوبة والخسران، ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب.
وأما القعود فإنه وإن استراح قليلاً، فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة، ويفوته ما يحصل للمجاهدين.
ثم قال: { وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ } أي: نصر وغنيمة { لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا } أي: يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم، ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية التي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها ولو على يد غيرهم من إخوانهم المؤمنين ويألمون بفقدها، ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم، فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط، ليست معه الروح الإيمانية المذكورة.
ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته، ولا يغلق عنهم أبوابها. بل من حصل منه غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه، فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله فقال: { فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ } هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها.
وقيل: إن معناه: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان، الصادقون في إيمانهم { الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ } أي: يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها.
فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطَّنوها على جهاد الأعداء، لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك.
وأما أولئك المتثاقلون، فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله تعالى: { قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا } إلى آخر الآيات. وقوله: { فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ } وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه "الذين" في محل نصب على المفعولية.
{ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله، ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله. { فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا } زيادة في إيمانه ودينه، وغنيمة، وثناء حسنا، وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
{ 75 } { وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا }
هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: { وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة.
ويدعون الله أن يجعل لهم وليًّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها، فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء.
 مواضيع مماثلة
مواضيع مماثلة» تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 76-100 ) وهي مدنية
» تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 101-125 ) وهي مدنية
» - تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 126-152 ) وهي مدنية
» تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 153-176 ) وهي مدنية
» تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 1-25 ) وهي مدنية
» تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 101-125 ) وهي مدنية
» - تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 126-152 ) وهي مدنية
» تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 153-176 ) وهي مدنية
» تفسير سورة النساء عدد آياتها 176 ( آية 1-25 ) وهي مدنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى