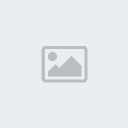تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 127-151 ) وهي مدنية
صفحة 1 من اصل 1
 تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 127-151 ) وهي مدنية
تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 127-151 ) وهي مدنية
لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ }
يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا، أي: جانبا منهم وركنا من أركانهم، إما بقتل، أو أسر، أو استيلاء على بلد، أو غنيمة مال، فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون، وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم، الأمر الثاني أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم، طمعا في المسلمين، ويمنوا أنفسهم ذلك، ويحرصوا عليه غاية الحرص، ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك، فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم، بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة، وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا بين هذين الأمرين، غير خارج عنهما إما نصر عليهم أو خذل لهم.
{ 128 - 129 } { لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ * وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
لما جرى يوم "أحد" ما جرى، وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم مصائب، رفع الله بها درجته، فشج رأسه وكسرت رباعيته، قال "كيف يفلح قوم شجوا نبيهم" وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، أنزل الله تعالى على رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله { ليس لك من الأمر شيء } إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم، وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمور، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهم، إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل، وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم، فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك، فعل، وقد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم، فهداهم للإسلام رضي الله عنهم، وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، وأن هذا شرك في العبادة، نقص في العقل، يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة، إن هذا لهو الضلال البعيد، وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه، ولم يذكر منهم سببا موجبا لذلك، ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده، من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة، ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم، ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية، فقال { أو يعذبهم فإنهم ظالمون } ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته، حيث وضع العقوبة موضعها، ولم يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسه، ولما نفى عن رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال { ولله ما في السماوات وما في الأرض } من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات كلها، وجميع ما في السماوات والأرض، الكل ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك، فليس لهم مثقال ذرة من الملك، وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه فيغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه، { ويعذب من يشاء } بأن يكله إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر ويعذبه على ذلك، ثم ختم الآية باسمين كريمين دالين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانه، فقال { والله غفور رحيم } ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه، ومغفرته غلبت مؤاخذته، فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه، فلم يختمها باسمين أحدهما دال على الرحمة، والثاني دال على النقمة، بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة، فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر، ولا يدرك لها وصف، فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين.
تم السفر الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من الله وإعانة، فله الحمد والشكر والثناء، وأسأله المزيد من فضله وكرمه وإحسانه، ويليه المجلد الثاني، أوله قول الباري جل جلاله { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } الآية وذلك في تسع وعشرين من شهر ربيع الأول من سنة 1343 ثلاث وأربعين وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا بقلم جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه وإخوانه المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
تم المجلد الأول بحمد الله
المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال تعالى:
{ 130 - 136 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ }
تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه -أولا- أن يعرف حده، وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله، فإذا عرف ذلك اجتهد، واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره، بحسب قدرته وإمكانه، وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده، وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي، وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت عن أوامر وخصال من خصال الخير، أمر الله [بها] وحث على فعلها، وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواهي حث على تركها.
ولعل الحكمة -والله أعلم- في إدخال هذه الآيات أثناء قصة "أحد" أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين، أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم، وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى: { وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا }
ثم قال: { بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم } الآيات.
فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى، التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى، ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ "التقوى" في هذه الآيات ثلاث مرات: مرة مطلقة وهي قوله: { أعدت للمتقين } ومرتين مقيدتين، فقال: { واتقوا الله } { واتقوا النار } فقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا } كل ما في القرآن من قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا } افعلوا كذا، أو اتركوا كذا، يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر، واجتناب ذلك النهي؛ لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح، فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية، ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين، على المعسر ولم يحصل منه شيء، قالوا له: إما أن تقضي ما عليك من الدين، وإما أن نزيد في المدة، ويزيد ما في ذمتك، فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك، اغتناما لراحته الحاضرة، ، فيزداد -بذلك- ما في ذمته أضعافا مضاعفة، من غير نفع وانتفاع.
ففي قوله: { أضعافًا مضاعفة } تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم.
وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر، وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى.
والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال: { واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين } بترك ما يوجب دخولها، من الكفر والمعاصي، على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها- وخصوصا المعاصي الكبار- تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله، فترك المعاصي ينجي من النار، ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن، ودخول الجنان، وحصول الرحمة، ولهذا قال: { وأطيعوا الله والرسول } بفعل الأوامر امتثالا، واجتناب النواهي { لعلكم ترحمون }
فطاعة الله وطاعة رسوله، من أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى: { ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة } الآيات.
ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها، التي أعدها الله للمتقين، فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها، ثم وصف المتقين وأعمالهم، فقال: { الذين ينفقون في السراء والضراء } أي: في حال عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل.
{ والكاظمين الغيظ } أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم -وهو امتلاء قلوبهم من الحنق، الموجب للانتقام بالقول والفعل-، هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم.
{ والعافين عن الناس } يدخل في العفو عن الناس، العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة، وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله، وعفا عن عباد الله رحمة بهم، وإحسانا إليهم، وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه، ويكون أجره على ربه الكريم، لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: { فمن عفا وأصلح فأجره على الله }
ثم ذكر حالة أعم من غيرها، وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال [تعالى]: { والله يحب المحسنين } والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق. [والإحسان إلى المخلوق، فالإحسان في عبادة الخالق].
فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"
وأما الإحسان إلى المخلوق، فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم، على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى، واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الله وحق عبيده.
ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم، فقال: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم } أي: صدر منهم أعمال [سيئة] كبيرة، أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار، وذكروا ربهم، وما توعد به العاصين ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم، والستر لعيوبهم، مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها، فلهذا قال: { ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون }
{ أولئك } الموصوفون بتلك الصفات { جزاؤهم مغفرة من ربهم } تزيل عنهم كل محذور { وجنات تجري من تحتها الأنهار } فيها من النعيم المقيم، والبهجة والسرور والبهاء، والخير والسرور، والقصور والمنازل الأنيقة العاليات، والأشجار المثمرة البهية، والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات، { خالدين فيها } لا يحولون عنها، ولا يبغون بها بدلا، ولا يغير ما هم فيه من النعيم، { ونعم أجر العاملين } عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا فـ "عند الصباح يحمد القوم السرى" وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا.
وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تدخل في الإيمان، خلافا للمرجئة، ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية، التي في سورة الحديد، نظير هذه الآيات، وهي قوله تعالى: { سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله } فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال: { أعدت للمتقين } ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون.ثم قال تعالى:
{ 137 - 138 } { قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ * هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ }
وهذه الآيات الكريمات، وما بعدها في قصة "أحد" يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم، ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة، امتحنوا، وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين، فلم يزالوا في مداولة ومجاولة، حتى جعل الله العاقبة للمتقين، والنصر لعباده المؤمنين، وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين، وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم.
{ فسيروا في الأرض } بأبدانكم وقلوبكم { فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين } فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم، وتبين لكل أحد خسارهم، وذهب عزهم وملكهم، وزال بذخهم وفخرهم، أفليس في هذا أعظم دليل، وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل؟"
وحكمة الله التي يمتحن بها عباده، ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم، ولهذا قال تعالى: { هذا بيان للناس } أي: دلالة ظاهرة، تبين للناس الحق من الباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين.
{ وهدى وموعظة للمتقين } لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم إلى سبيل الرشاد، وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي، وأما باقي الناس فهي بيان لهم، تقوم [به] عليهم الحجة من الله، ليهلك من هلك عن بينة.
ويحتمل أن الإشارة في قوله: { هذا بيان للناس } للقرآن العظيم، والذكر الحكيم، وأنه بيان للناس عموما، وهدى وموعظة للمتقين خصوصا، وكلا المعنيين حق.
{ 139 - 143 } { وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ *وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ * وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ }
يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين، ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم: { ولا تهنوا ولا تحزنوا } أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم، عندما أصابتكم المصيبة، وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب، والوهن على الأبدان، زيادة مصيبة عليكم، وعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبروها، وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم، وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن، وهم الأعلون في الإيمان، ورجاء نصر الله وثوابه، فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي منه ذلك، ولهذا قال [تعالى]: { وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين }
ثم سلَّاهم بما حصل لهم من الهزيمة، وبيَّن الحكم العظيمة المترتبة على ذلك، فقال: { إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله } فأنتم وإياهم قد تساويتم في القرح، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى: { إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون }
ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، فيداول الله الأيام بين الناس، يوم لهذه الطائفة، ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة، فإنها خالصة للذين آمنوا.
{ وليعلم الله الذين آمنوا } هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء، ليتبين المؤمن من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء، تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام، في الضراء والسراء، واليسر والعسر، ممن ليس كذلك.
{ ويتخذ منكم شهداء } وهذا أيضا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين، أن قيَّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس، لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم، { والله لا يحب الظالمين } الذين ظلموا أنفسهم، وتقاعدوا عن القتال في سبيله، وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين، وأنهم مبغضون لله، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله.
{ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين }
{ وليمحص الله الذين آمنوا } وهذا أيضا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب، ويزيل العيوب، وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين، فيتخلصون منهم، ويعرفون المؤمن من المنافق، ومن الحكم أيضا أنه يقدر ذلك، ليمحق الكافرين، أي: ليكون سببا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة، فإنهم إذا انتصروا، بغوا، وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم، يستحقون به المعاجلة بالعقوبة، رحمة بعباده المؤمنين.
ثم قال تعالى: { أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين } هذا استفهام إنكاري، أي: لا تظنوا، ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب، وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته، والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها، وتمرينها عليها ومعرفة ما تئول إليه، تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها، ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله، فقال: { ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه } وذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر يتمنون أن يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهم، قال الله [تعالى] لهم: { فقد رأيتموه } أي: رأيتم ما تمنيتم بأعينكم { وأنتم تنظرون } فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق ولا تحسن، خصوصا لمن تمنى ذلك، وحصل له ما تمنى، فإن الواجب عليه بذل الجهد، واستفراغ الوسع في ذلك.
وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة، ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم، ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها، والله أعلم.
ثم قال تعالى: { 144 - 145 } { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ }
يقول تعالى: { وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل } أي: ليس ببدع من الرسل، بل هو من جنس الرسل الذين قبله، وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم وتنفيذ أوامره، ليسوا بمخلدين، وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله، بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال، ولهذا قال: { أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم } بترك ما جاءكم من إيمان أو جهاد، أو غير ذلك.
قال [الله] تعالى: { ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا } إنما يضر نفسه، وإلا فالله تعالى غني عنه، وسيقيم دينه، ويعز عباده المؤمنين، فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه، مدح من ثبت مع رسوله، وامتثل أمر ربه، فقال: { وسيجزي الله الشاكرين } والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال.
وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه، فقدُ رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله، والجهاد عنه، بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم، وتستقيم أمورهم.
وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر، وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم سادات الشاكرين.
ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه، فمن حتَّم عليه بالقدر أن يموت، مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه، فلو أتى من الأسباب كل سبب، لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى: { إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون }
ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إراداتهم، فقال: { ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها }
قال الله تعالى: { كلاًّ نمدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا }
{ وسنجزي الشاكرين } ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر، قلة وكثرة وحسنا.
{ 146 - 148 } { وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }
هذا تسلية للمؤمنين، وحث على الاقتداء بهم، والفعل كفعلهم، وأن هذا أمر قد كان متقدما، لم تزل سنة الله جارية بذلك، فقال: { وكأين من نبي } أي: وكم من نبي { قاتل معه ربيون كثير } أي: جماعات كثيرون من أتباعهم، الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة، فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك.
{ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا } أي: ما ضعفت قلوبهم، ولا وهنت أبدانهم، ولا استكانوا، أي: ذلوا لعدوهم، بل صبروا وثبتوا، وشجعوا أنفسهم، ولهذا قال: { والله يحب الصابرين }
ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم، فقال: { وما كان قولهم } أي: في تلك المواطن الصعبة { إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا } والإسراف: هو مجاوزة الحد إلى ما حرم، علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها.
ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله، وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين، وأن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين الصبر وترك ضده، والتوبة والاستغفار، والاستنصار بربهم، لا جرم أن الله نصرهم، وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: { فآتاهم الله ثواب الدنيا } من النصر والظفر والغنيمة، { وحُسن ثواب الآخرة } وهو الفوز برضا ربهم، والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات، وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال، فجازاهم بأحسن الجزاء، فلهذا قال: { والله يحب المحسنين } في عبادة الخالق ومعاملة الخلق، ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء، كفعل هؤلاء الموصوفين
ثم قال تعالى:
{ 149 - 151 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ * سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ }
وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين، فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم [قصدهم] ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران.
ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذلك، وبشارة بأنه سيتولى أمورهم بلطفه، ويعصمهم من أنواع الشرور.
وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد، فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم، وقد فعل تعالى.
وذلك أن المشركين -بعدما انصرفوا من وقعة "أحد" - تشاوروا بينهم، وقالوا: كيف ننصرف، بعد أن قتلنا منهم من قتلنا، وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلك، فألقى الله الرعب في قلوبهم، فانصرفوا خائبين، ولا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهذا من الثاني.
ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين، فقال: { بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا } أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام، التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة، من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن، فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين، لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق، هذا حاله في الدنيا، وأما في الآخرة فأشد وأعظم، ولهذا قال: { ومأواهم النار } أي: مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج، { وبئس مثوى الظالمين } بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم.
يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا، أي: جانبا منهم وركنا من أركانهم، إما بقتل، أو أسر، أو استيلاء على بلد، أو غنيمة مال، فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون، وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم، الأمر الثاني أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم، طمعا في المسلمين، ويمنوا أنفسهم ذلك، ويحرصوا عليه غاية الحرص، ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك، فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم، بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة، وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا بين هذين الأمرين، غير خارج عنهما إما نصر عليهم أو خذل لهم.
{ 128 - 129 } { لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ * وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
لما جرى يوم "أحد" ما جرى، وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم مصائب، رفع الله بها درجته، فشج رأسه وكسرت رباعيته، قال "كيف يفلح قوم شجوا نبيهم" وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، أنزل الله تعالى على رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله { ليس لك من الأمر شيء } إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم، وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمور، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهم، إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل، وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم، فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك، فعل، وقد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم، فهداهم للإسلام رضي الله عنهم، وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، وأن هذا شرك في العبادة، نقص في العقل، يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة، إن هذا لهو الضلال البعيد، وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه، ولم يذكر منهم سببا موجبا لذلك، ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده، من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة، ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم، ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية، فقال { أو يعذبهم فإنهم ظالمون } ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته، حيث وضع العقوبة موضعها، ولم يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسه، ولما نفى عن رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال { ولله ما في السماوات وما في الأرض } من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات كلها، وجميع ما في السماوات والأرض، الكل ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك، فليس لهم مثقال ذرة من الملك، وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه فيغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه، { ويعذب من يشاء } بأن يكله إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر ويعذبه على ذلك، ثم ختم الآية باسمين كريمين دالين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانه، فقال { والله غفور رحيم } ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه، ومغفرته غلبت مؤاخذته، فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه، فلم يختمها باسمين أحدهما دال على الرحمة، والثاني دال على النقمة، بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة، فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر، ولا يدرك لها وصف، فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين.
تم السفر الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من الله وإعانة، فله الحمد والشكر والثناء، وأسأله المزيد من فضله وكرمه وإحسانه، ويليه المجلد الثاني، أوله قول الباري جل جلاله { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } الآية وذلك في تسع وعشرين من شهر ربيع الأول من سنة 1343 ثلاث وأربعين وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا بقلم جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه وإخوانه المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
تم المجلد الأول بحمد الله
المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال تعالى:
{ 130 - 136 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ }
تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه -أولا- أن يعرف حده، وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله، فإذا عرف ذلك اجتهد، واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره، بحسب قدرته وإمكانه، وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده، وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي، وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت عن أوامر وخصال من خصال الخير، أمر الله [بها] وحث على فعلها، وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواهي حث على تركها.
ولعل الحكمة -والله أعلم- في إدخال هذه الآيات أثناء قصة "أحد" أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين، أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم، وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى: { وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا }
ثم قال: { بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم } الآيات.
فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى، التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى، ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ "التقوى" في هذه الآيات ثلاث مرات: مرة مطلقة وهي قوله: { أعدت للمتقين } ومرتين مقيدتين، فقال: { واتقوا الله } { واتقوا النار } فقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا } كل ما في القرآن من قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا } افعلوا كذا، أو اتركوا كذا، يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر، واجتناب ذلك النهي؛ لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به، المستلزم لأعمال الجوارح، فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية، ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين، على المعسر ولم يحصل منه شيء، قالوا له: إما أن تقضي ما عليك من الدين، وإما أن نزيد في المدة، ويزيد ما في ذمتك، فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك، اغتناما لراحته الحاضرة، ، فيزداد -بذلك- ما في ذمته أضعافا مضاعفة، من غير نفع وانتفاع.
ففي قوله: { أضعافًا مضاعفة } تنبيه على شدة شناعته بكثرته، وتنبيه لحكمة تحريمه، وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم.
وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر، وبقاء ما في ذمته من غير زيادة، فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف، فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه، لأن تركه من موجبات التقوى.
والفلاح متوقف على التقوى، فلهذا قال: { واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين } بترك ما يوجب دخولها، من الكفر والمعاصي، على اختلاف درجاتها، فإن المعاصي كلها- وخصوصا المعاصي الكبار- تجر إلى الكفر، بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهله، فترك المعاصي ينجي من النار، ويقي من سخط الجبار، وأفعال الخير والطاعة توجب رضا الرحمن، ودخول الجنان، وحصول الرحمة، ولهذا قال: { وأطيعوا الله والرسول } بفعل الأوامر امتثالا، واجتناب النواهي { لعلكم ترحمون }
فطاعة الله وطاعة رسوله، من أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى: { ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة } الآيات.
ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها، التي أعدها الله للمتقين، فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها، ثم وصف المتقين وأعمالهم، فقال: { الذين ينفقون في السراء والضراء } أي: في حال عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل.
{ والكاظمين الغيظ } أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم -وهو امتلاء قلوبهم من الحنق، الموجب للانتقام بالقول والفعل-، هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم.
{ والعافين عن الناس } يدخل في العفو عن الناس، العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة، وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله، وعفا عن عباد الله رحمة بهم، وإحسانا إليهم، وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه، ويكون أجره على ربه الكريم، لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: { فمن عفا وأصلح فأجره على الله }
ثم ذكر حالة أعم من غيرها، وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال [تعالى]: { والله يحب المحسنين } والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق. [والإحسان إلى المخلوق، فالإحسان في عبادة الخالق].
فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"
وأما الإحسان إلى المخلوق، فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم، على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى، واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الله وحق عبيده.
ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم، فقال: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم } أي: صدر منهم أعمال [سيئة] كبيرة، أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار، وذكروا ربهم، وما توعد به العاصين ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم، والستر لعيوبهم، مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها، فلهذا قال: { ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون }
{ أولئك } الموصوفون بتلك الصفات { جزاؤهم مغفرة من ربهم } تزيل عنهم كل محذور { وجنات تجري من تحتها الأنهار } فيها من النعيم المقيم، والبهجة والسرور والبهاء، والخير والسرور، والقصور والمنازل الأنيقة العاليات، والأشجار المثمرة البهية، والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات، { خالدين فيها } لا يحولون عنها، ولا يبغون بها بدلا، ولا يغير ما هم فيه من النعيم، { ونعم أجر العاملين } عملوا لله قليلا فأجروا كثيرا فـ "عند الصباح يحمد القوم السرى" وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا.
وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة، على أن الأعمال تدخل في الإيمان، خلافا للمرجئة، ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية، التي في سورة الحديد، نظير هذه الآيات، وهي قوله تعالى: { سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله } فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسله، وهنا قال: { أعدت للمتقين } ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية، فدل على أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون.ثم قال تعالى:
{ 137 - 138 } { قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ * هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ }
وهذه الآيات الكريمات، وما بعدها في قصة "أحد" يعزي تعالى عباده المؤمنين ويسليهم، ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة، امتحنوا، وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين، فلم يزالوا في مداولة ومجاولة، حتى جعل الله العاقبة للمتقين، والنصر لعباده المؤمنين، وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين، وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم.
{ فسيروا في الأرض } بأبدانكم وقلوبكم { فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين } فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خوت ديارهم، وتبين لكل أحد خسارهم، وذهب عزهم وملكهم، وزال بذخهم وفخرهم، أفليس في هذا أعظم دليل، وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل؟"
وحكمة الله التي يمتحن بها عباده، ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم، ولهذا قال تعالى: { هذا بيان للناس } أي: دلالة ظاهرة، تبين للناس الحق من الباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة، وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين.
{ وهدى وموعظة للمتقين } لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم إلى سبيل الرشاد، وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي، وأما باقي الناس فهي بيان لهم، تقوم [به] عليهم الحجة من الله، ليهلك من هلك عن بينة.
ويحتمل أن الإشارة في قوله: { هذا بيان للناس } للقرآن العظيم، والذكر الحكيم، وأنه بيان للناس عموما، وهدى وموعظة للمتقين خصوصا، وكلا المعنيين حق.
{ 139 - 143 } { وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ *وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ * وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ }
يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين، ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم: { ولا تهنوا ولا تحزنوا } أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم، عندما أصابتكم المصيبة، وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب، والوهن على الأبدان، زيادة مصيبة عليكم، وعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبروها، وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم، وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن، وهم الأعلون في الإيمان، ورجاء نصر الله وثوابه، فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي منه ذلك، ولهذا قال [تعالى]: { وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين }
ثم سلَّاهم بما حصل لهم من الهزيمة، وبيَّن الحكم العظيمة المترتبة على ذلك، فقال: { إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله } فأنتم وإياهم قد تساويتم في القرح، ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى: { إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون }
ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، فيداول الله الأيام بين الناس، يوم لهذه الطائفة، ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا منقضية فانية، وهذا بخلاف الدار الآخرة، فإنها خالصة للذين آمنوا.
{ وليعلم الله الذين آمنوا } هذا أيضا من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء، ليتبين المؤمن من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده، فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء، تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام، في الضراء والسراء، واليسر والعسر، ممن ليس كذلك.
{ ويتخذ منكم شهداء } وهذا أيضا من بعض الحكم، لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل، ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابها، فهذا من رحمته بعباده المؤمنين، أن قيَّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس، لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم، { والله لا يحب الظالمين } الذين ظلموا أنفسهم، وتقاعدوا عن القتال في سبيله، وكأن في هذا تعريضا بذم المنافقين، وأنهم مبغضون لله، ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله.
{ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين }
{ وليمحص الله الذين آمنوا } وهذا أيضا من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم، يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب، ويزيل العيوب، وليمحص الله أيضا المؤمنين من غيرهم من المنافقين، فيتخلصون منهم، ويعرفون المؤمن من المنافق، ومن الحكم أيضا أنه يقدر ذلك، ليمحق الكافرين، أي: ليكون سببا لمحقهم واستئصالهم بالعقوبة، فإنهم إذا انتصروا، بغوا، وازدادوا طغيانا إلى طغيانهم، يستحقون به المعاجلة بالعقوبة، رحمة بعباده المؤمنين.
ثم قال تعالى: { أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين } هذا استفهام إنكاري، أي: لا تظنوا، ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب، وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته، والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها، وتمرينها عليها ومعرفة ما تئول إليه، تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها، ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله، فقال: { ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه } وذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدر يتمنون أن يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه جهدهم، قال الله [تعالى] لهم: { فقد رأيتموه } أي: رأيتم ما تمنيتم بأعينكم { وأنتم تنظرون } فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق ولا تحسن، خصوصا لمن تمنى ذلك، وحصل له ما تمنى، فإن الواجب عليه بذل الجهد، واستفراغ الوسع في ذلك.
وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تمني الشهادة، ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم، ولم ينكر عليهم، وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاها، والله أعلم.
ثم قال تعالى: { 144 - 145 } { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ }
يقول تعالى: { وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل } أي: ليس ببدع من الرسل، بل هو من جنس الرسل الذين قبله، وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم وتنفيذ أوامره، ليسوا بمخلدين، وليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله، بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال، ولهذا قال: { أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم } بترك ما جاءكم من إيمان أو جهاد، أو غير ذلك.
قال [الله] تعالى: { ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا } إنما يضر نفسه، وإلا فالله تعالى غني عنه، وسيقيم دينه، ويعز عباده المؤمنين، فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه، مدح من ثبت مع رسوله، وامتثل أمر ربه، فقال: { وسيجزي الله الشاكرين } والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال.
وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه، فقدُ رئيس ولو عظم، وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله، والجهاد عنه، بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم، وتستقيم أمورهم.
وفي هذه الآية أيضا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر، وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم هم سادات الشاكرين.
ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه، فمن حتَّم عليه بالقدر أن يموت، مات ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه، فلو أتى من الأسباب كل سبب، لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى: { إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون }
ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إراداتهم، فقال: { ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها }
قال الله تعالى: { كلاًّ نمدُّ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا }
{ وسنجزي الشاكرين } ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر، قلة وكثرة وحسنا.
{ 146 - 148 } { وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }
هذا تسلية للمؤمنين، وحث على الاقتداء بهم، والفعل كفعلهم، وأن هذا أمر قد كان متقدما، لم تزل سنة الله جارية بذلك، فقال: { وكأين من نبي } أي: وكم من نبي { قاتل معه ربيون كثير } أي: جماعات كثيرون من أتباعهم، الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة، فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك.
{ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا } أي: ما ضعفت قلوبهم، ولا وهنت أبدانهم، ولا استكانوا، أي: ذلوا لعدوهم، بل صبروا وثبتوا، وشجعوا أنفسهم، ولهذا قال: { والله يحب الصابرين }
ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم، فقال: { وما كان قولهم } أي: في تلك المواطن الصعبة { إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا } والإسراف: هو مجاوزة الحد إلى ما حرم، علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها.
ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبر، بل اعتمدوا على الله، وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين، وأن ينصرهم عليهم، فجمعوا بين الصبر وترك ضده، والتوبة والاستغفار، والاستنصار بربهم، لا جرم أن الله نصرهم، وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: { فآتاهم الله ثواب الدنيا } من النصر والظفر والغنيمة، { وحُسن ثواب الآخرة } وهو الفوز برضا ربهم، والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات، وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال، فجازاهم بأحسن الجزاء، فلهذا قال: { والله يحب المحسنين } في عبادة الخالق ومعاملة الخلق، ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء، كفعل هؤلاء الموصوفين
ثم قال تعالى:
{ 149 - 151 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ * سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ }
وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين، فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم [قصدهم] ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران.
ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم، ففيه إخبار لهم بذلك، وبشارة بأنه سيتولى أمورهم بلطفه، ويعصمهم من أنواع الشرور.
وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليا وناصرا من دون كل أحد، فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب، وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم، وقد فعل تعالى.
وذلك أن المشركين -بعدما انصرفوا من وقعة "أحد" - تشاوروا بينهم، وقالوا: كيف ننصرف، بعد أن قتلنا منهم من قتلنا، وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلك، فألقى الله الرعب في قلوبهم، فانصرفوا خائبين، ولا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهذا من الثاني.
ثم ذكر السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين، فقال: { بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا } أي: ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام، التي اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة، من غير حجة ولا برهان، وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن، فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين، لا يعتمد على ركن وثيق، وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق، هذا حاله في الدنيا، وأما في الآخرة فأشد وأعظم، ولهذا قال: { ومأواهم النار } أي: مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج، { وبئس مثوى الظالمين } بسبب ظلمهم وعدوانهم صارت النار مثواهم.
 مواضيع مماثلة
مواضيع مماثلة» - تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 1-25 ) وهي مدنية
» - تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 26-58 ) وهي مدنية
» تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 59-77 ) وهي مدنية
» تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 78-101 ) وهي مدنية
» تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 102-126 ) وهي مدنية
» - تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 26-58 ) وهي مدنية
» تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 59-77 ) وهي مدنية
» تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 78-101 ) وهي مدنية
» تفسير سورة آل عمران عدد آياتها 200 ( آية 102-126 ) وهي مدنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى