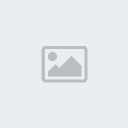تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 177-202 ) وهي مدنية
صفحة 1 من اصل 1
 تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 177-202 ) وهي مدنية
تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 177-202 ) وهي مدنية
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ }
يقول تعالى: { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ } أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد, فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " ونحو ذلك.
{ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ } أي: بأنه إله واحد, موصوف بكل صفة كمال, منزه عن كل نقص.
{ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } وهو كل ما أخبر الله به في كتابه, أو أخبر به الرسول, مما يكون بعد الموت.
{ وَالْمَلَائِكَةِ } الذين وصفهم الله لنا في كتابه, ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم { وَالْكِتَابِ } أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله, وأعظمها القرآن, فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام، { وَالنَّبِيِّينَ } عموما, خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم.
{ وَآتَى الْمَالَ } وهو كل ما يتموله الإنسان من مال, قليلا كان أو كثيرا، أي: أعطى المال { عَلَى حُبِّهِ } أي: حب المال ، بيَّن به أن المال محبوب للنفوس, فلا يكاد يخرجه العبد.
فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى, كان هذا برهانا لإيمانه، ومن إيتاء المال على حبه, أن يتصدق وهو صحيح شحيح, يأمل الغنى, ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة, كانت أفضل, لأنه في هذه الحال, يحب إمساكه, لما يتوهمه من العدم والفقر.
وكذلك إخراج النفيس من المال, وما يحبه من ماله كما قال تعالى: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه.
ثم ذكر المنفق عليهم, وهم أولى الناس ببرك وإحسانك. من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم, وتفرح بسرورهم, الذين يتناصرون ويتعاقلون، فمن أحسن البر وأوفقه, تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي, على حسب قربهم وحاجتهم.
ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم, وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته [تعالى] بالعباد, الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده، فالله قد أوصى العباد, وفرض عليهم في أموالهم, الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره, رُحِمَ يتيمه.
{ وَالْمَسَاكِين } وهم الذين أسكنتهم الحاجة, وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء, بما يدفع مسكنتهم أو يخففها, بما يقدرون عليه, وبما يتيسر، { وَابْنَ السَّبِيلِ } وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال, ما يعينه على سفره, لكونه مظنة الحاجة, وكثرة المصارف، فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته, وخوله من نعمته, أن يرحم أخاه الغريب, الذي بهذه الصفة, على حسب استطاعته, ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره, أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها.
{ وَالسَّائِلِينَ } أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج, توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية, أو ضريبة عليه من ولاة الأمور, أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة, كالمساجد, والمدارس, والقناطر, ونحو ذلك, فهذا له حق وإن كان غنيا { وَفِي الرِّقَابِ } فيدخل فيه العتق والإعانة عليه, وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده, وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة.
{ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ } قد تقدم مرارا, أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة, لكونهما أفضل العبادات, وأكمل القربات, عبادات قلبية, وبدنية, ومالية, وبهما يوزن الإيمان, ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان.
{ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا } والعهد: هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه. فدخل في ذلك حقوق الله كلها, لكون الله ألزم بها عباده والتزموها, ودخلوا تحت عهدتها, ووجب عليهم أداؤها, وحقوق العباد, التي أوجبها الله عليهم, والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور, ونحو ذلك.
{ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ } أي: الفقر, لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة, لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره.
فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم، وإن عرى أو كاد تألم, وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم, وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم.
فكل هذه ونحوها, مصائب, يؤمر بالصبر عليها, والاحتساب, ورجاء الثواب من الله عليها.
{ وَالضَّرَّاءِ } أي: المرض على اختلاف أنواعه, من حمى, وقروح, ورياح, ووجع عضو, حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك, فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن النفس تضعف, والبدن يألم, وذلك في غاية المشقة على النفوس, خصوصا مع تطاول ذلك, فإنه يؤمر بالصبر, احتسابا لثواب الله [تعالى].
{ وَحِينَ الْبَأْسِ } أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم, لأن الجلاد, يشق غاية المشقة على النفس, ويجزع الإنسان من القتل, أو الجراح أو الأسر, فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا, ورجاء لثواب الله [تعالى] الذي منه النصر والمعونة, التي وعدها الصابرين.
{ أُولَئِكَ } أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة, والأعمال التي هي آثار الإيمان, وبرهانه ونوره, والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية، فأولئك هم { الَّذِينَ صَدَقُوا } في إيمانهم, لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، { وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } لأنهم تركوا المحظور, وفعلوا المأمور؛ لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير, تضمنا ولزوما, لأن الوفاء بالعهد, يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها, كان بما سواها أقوم, فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون.
وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة, من الثواب الدنيوي والأخروي, مما لا يمكن تفصيله في [مثل] هذا الموضع.
{ 178 - 179 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }
يمتن تعالى على عباده المؤمنين, بأنه فرض عليهم { الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } أي: المساواة فيه, وأن يقتل القاتل على الصفة, التي قتل عليها المقتول, إقامة للعدل والقسط بين العباد.
وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين, فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول, إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل, وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد, ويمنعوا الولي من الاقتصاص, كما عليه عادة الجاهلية, ومن أشبههم من إيواء المحدثين.
ثم بيَّن تفصيل ذلك فقال: { الْحُرُّ بِالْحُرِّ } يدخل بمنطقوقها, الذكر بالذكر، { وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى } والأنثى بالذكر, والذكر بالأنثى, فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله: " الأنثى بالأنثى " مع دلالة السنة, على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا، فلا يقتلان بالولد, لورود السنة بذلك، مع أن في قوله: { الْقِصَاصُ } ما يدل على أنه ليس من العدل, أن يقتل الوالد بولده، ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة, ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله, أو أذية شديدة جدا من الولد له.
وخرج من العموم أيضا, الكافر بالسنة, مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة.
وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد, ذكرا كان أو أنثى, تساوت قيمتهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر, لا يقتل بالعبد, لكونه غير مساو له، والأنثى بالأنثى, أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة, وتقدم وجه ذلك.
وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل, وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية, أو عفا بعض الأولياء, فإنه يسقط القصاص, وتجب الدية, وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي.
فإذا عفا عنه وجب على الولي, [أي: ولي المقتول] أن يتبع القاتل { بِالْمَعْرُوفِ } من غير أن يشق عليه, ولا يحمله ما لا يطيق, بل يحسن الاقتضاء والطلب, ولا يحرجه.
وعلى القاتل { أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } من غير مطل ولا نقص, ولا إساءة فعلية أو قولية, فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو, إلا الإحسان بحسن القضاء، وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق, بالأداء بإحسان
وفي قوله: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ } ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا.
وفي قوله: { أَخِيهِ } دليل على أن القاتل لا يكفر, لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان, فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر, لا يكفر بها فاعلها, وإنما ينقص بذلك إيمانه.
وإذا عفا أولياء المقتول, أو عفا بعضهم, احتقن دم القاتل, وصار معصوما منهم ومن غيرهم, ولهذا قال: { فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ } أي: بعد العفو { فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } أي: في الآخرة، وأما قتله وعدمه, فيؤخذ مما تقدم, لأنه قتل مكافئا له, فيجب قتله بذلك.
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل, فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله, ولا يجوز العفو عنه, وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول, لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.
ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } أي: تنحقن بذلك الدماء, وتنقمع به الأشقياء, لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل, لا يكاد يصدر منه القتل, وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر, فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل, لم يحصل انكفاف الشر, الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية, فيها من النكاية والانزجار, ما يدل على حكمة الحكيم الغفار، ونكَّر " الحياة " لإفادة التعظيم والتكثير.
ولما كان هذا الحكم, لا يعرف حقيقته, إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة, خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى, يحب من عباده, أن يعملوا أفكارهم وعقولهم, في تدبر ما في أحكامه من الحكم, والمصالح الدالة على كماله, وكمال حكمته وحمده, وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة, فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب, وناداهم رب الأرباب, وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون.
وقوله: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة, أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله, ويعظم معاصيه فيتركها, فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.
{ 180 - 182 } { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
أي: فرض الله عليكم, يا معشر المؤمنين { إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ } أي: أسبابه, كالمرض المشرف على الهلاك, وحضور أسباب المهالك، وكان قد { تَرَكَ خَيْرًا } [أي: مالا] وهو المال الكثير عرفا, فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف, على قدر حاله من غير سرف, ولا اقتصار على الأبعد, دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة, ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل.
وقوله: { حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } دل على وجوب ذلك, لأن الحق هو: الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى.
واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين, مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة, ردها الله تعالى إلى العرف الجاري.
ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث, بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف, فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة, ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين, لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا, واختلف المورد.
فبهذا الجمع, يحصل الاتفاق, والجمع بين الآيات, لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ, الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية, لما يتوهمه أن من بعده, قد يبدل ما وصى به قال تعالى: { فَمَنْ بَدَّلَهُ } أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم { بَعْدَمَا سَمِعَهُ } [أي:] بعدما عقله, وعرف طرقه وتنفيذه، { فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } وإلا فالموصي وقع أجره على الله, وإنما الإثم على المبدل المغير.
{ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ } يسمع سائر الأصوات, ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه, وأن لا يجور في وصيته، { عَلِيمٌ } بنيته, وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي, وعلم الله من نيته ذلك, أثابه ولو أخطأ، وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به, مطلع على ما فعله, فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة.
وأما الوصية التي فيها حيف وجنف, وإثم، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها, أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل, وأن ينهاه عن الجور والجنف, وهو: الميل بها عن خطأ, من غير تعمد, والإثم: وهو التعمد لذلك.
فإن لم يفعل ذلك, فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم, ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة, ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم فهذا قد فعل معروفا عظيما, وليس عليهم إثم, كما على مبدل الوصية الجائزة، ولهذا قال: { إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ } أي: يغفر جميع الزلات, ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه, ومنه مغفرته لمن غض من نفسه, وترك بعض حقه لأخيه, لأن من سامح, سامحه الله، غفور لميتهم الجائر في وصيته, إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته، رحيم بعباده, حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون، فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية, وعلى بيان من هي له, وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة, والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة.
{ 183 - 185 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
يخبر تعالى بما منَّ به على عباده, بأنه فرض عليهم الصيام, كما فرضه على الأمم السابقة, لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان.
وفيه تنشيط لهذه الأمة, بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال, والمسارعة إلى صالح الخصال, وأنه ليس من الأمور الثقيلة, التي اختصيتم بها.
ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى, لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه.
فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها, التي تميل إليها نفسه, متقربا بذلك إلى الله, راجيا بتركها, ثوابه، فهذا من التقوى.
ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى, فيترك ما تهوى نفسه, مع قدرته عليه, لعلمه باطلاع الله عليه، ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان, فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم, فبالصيام, يضعف نفوذه, وتقل منه المعاصي، ومنها: أن الصائم في الغالب, تكثر طاعته, والطاعات من خصال التقوى، ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع, أوجب له ذلك, مواساة الفقراء المعدمين, وهذا من خصال التقوى.
ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام, أخبر أنه أيام معدودات, أي: قليلة في غاية السهولة.
ثم سهل تسهيلا آخر. فقال: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وذلك للمشقة, في الغالب, رخص الله لهما, في الفطر.
ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن, أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض, وانقضى السفر, وحصلت الراحة.
وفي قوله: { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ } فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان, كاملا كان, أو ناقصا, وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة, عن أيام طويلة حارة كالعكس.
وقوله: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } أي: يطيقون الصيام { فِدْيَةٌ } عن كل يوم يفطرونه { طَعَامُ مِسْكِينٍ } وهذا في ابتداء فرض الصيام, لما كانوا غير معتادين للصيام, وكان فرضه حتما, فيه مشقة عليهم, درجهم الرب الحكيم, بأسهل طريق، وخيَّر المطيق للصوم بين أن يصوم, وهو أفضل, أو يطعم، ولهذا قال: { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ }
ثم بعد ذلك, جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق, يفطر ويقضيه في أيام أخر [وقيل: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } أي: يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة, كالشيخ الكبير, فدية عن كل يوم مسكين وهذا هو الصحيح]
{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } أي: الصوم المفروض عليكم, هو شهر رمضان, الشهر العظيم, الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم, المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية, وتبيين الحق بأوضح بيان, والفرقان بين الحق والباطل, والهدى والضلال, وأهل السعادة وأهل الشقاوة.
فحقيق بشهر, هذا فضله, وهذا إحسان الله عليكم فيه, أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام.
فلما قرره, وبين فضيلته, وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر.
ولما كان النسخ للتخيير, بين الصيام والفداء خاصة, أعاد الرخصة للمريض والمسافر, لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة [فقال] { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } أي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير, ويسهلها أشد تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله.
وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله, سهَّله تسهيلا آخر, إما بإسقاطه, أو تخفيفه بأنواع التخفيفات.
وهذه جملة لا يمكن تفصيلها, لأن تفاصيلها, جميع الشرعيات, ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات.
{ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ } وهذا - والله أعلم - لئلا يتوهم متوهم, أن صيام رمضان, يحصل المقصود منه ببعضه, دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله [تعالى] عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده, وبالتكبير عند انقضائه, ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد.
{ 186 } { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }
هذا جواب سؤال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله, أقريب ربنا فنناجيه, أم بعيد فنناديه؟ فنزل: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ } لأنه تعالى, الرقيب الشهيد, المطلع على السر وأخفى, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, فهو قريب أيضا من داعيه, بالإجابة، ولهذا قال: { أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } والدعاء نوعان: دعاء عبادة, ودعاء مسألة.
والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه, وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق.
فمن دعا ربه بقلب حاضر, ودعاء مشروع, ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء, كأكل الحرام ونحوه, فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء, وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية, والإيمان به, الموجب للاستجابة، فلهذا قال: { فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة, ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره, سبب لحصول العلم كما قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا
{ 187 } ثم قال تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }
كان في أول فرض الصيام، يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم، فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به.
{ فتاب } الله { عليكم } بأن وسع لكم أمرا كان - لولا توسعته - موجبا للإثم { وعفا عنكم } ما سلف من التخون.
{ فالآن } بعد هذه الرخصة والسعة من الله { باشروهن } وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك.
{ وابتغوا ما كتب الله لكم } أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح.
ومما كتب الله لكم ليلة القدر، الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك.
{ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه.
وفيه: دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد.
وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق.
{ ثم } إذا طلع الفجر { أتموا الصيام } أي: الإمساك عن المفطرات { إلى الليل } وهو غروب الشمس ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله: { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } أي: وأنتم متصفون بذلك، ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله [تعالى]، وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد.
ويستفاد من تعريف المساجد، أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس.
وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف.
{ تلك } المذكورات - وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطء على المعتكف، ونحو ذلك من المحرمات { حدود الله } التي حدها لعباده، ونهاهم عنها، فقال: { فلا تقربوها } أبلغ من قوله: " فلا تفعلوها " لأن القربان، يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه، والنهي عن وسائله الموصلة إليه.
والعبد مأمور بترك المحرمات، والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها، وأما الأوامر فيقول الله فيها: { تلك حدود الله فلا تعتدوها } فينهى عن مجاوزتها.
{ كذلك } أي: بيَّن [الله] لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين، وأوضحها لهم أكمل إيضاح.
{ يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون } فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه، فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته، لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى.
{ 188 } { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }
أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافها إليهم, لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه, ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة.
ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق, ونوعا بباطل, وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل, قيده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية, أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا, أخذها على وجه المعاوضة, بمعاوضة محرمة, كعقود الربا, والقمار كلها, فإنها من أكل المال بالباطل, لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة, ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات, والأوقاف، والوصايا, لمن ليس له حق منها, أو فوق حقه.
فكل هذا ونحوه, من أكل المال بالباطل, فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع, وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة, غلبت حجة المحق, وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم, لا يبيح محرما, ولا يحلل حراما, إنما يحكم على نحو مما يسمع, وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة, ولا شبهة, ولا استراحة.
فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة, وحكم له بذلك, فإنه لا يحل له, ويكون آكلا لمال غيره, بالباطل والإثم, وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته, وأشد في نكاله.
وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه, لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: { وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا }
{ 189 } { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
يقول تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ } جمع - هلال - ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتها، { قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ } أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر, ثم يتزايد إلى نصفه, ثم يشرع في النقص إلى كماله, وهكذا, ليعرف الناس بذلك, مواقيت عباداتهم من الصيام, وأوقات الزكاة, والكفارات, وأوقات الحج.
ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات, ويستغرق أوقاتا كثيرة قال: { وَالْحَجِّ } وكذلك تعرف بذلك, أوقات الديون المؤجلات, ومدة الإجارات, ومدة العدد والحمل, وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، فجعله تعالى, حسابا, يعرفه كل أحد, من صغير, وكبير, وعالم, وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية, لم يعرفه إلا النادر من الناس.
{ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا } وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب, إذا أحرموا, لم يدخلوا البيوت من أبوابها, تعبدا بذلك, وظنا أنه بر. فأخبر الله أنه ليس ببر لأن الله تعالى, لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله, فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم, التي هي قاعدة من قواعد الشرع.
ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور, أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب, الذي قد جعل له موصلا، فالآمر بالمعروف, والناهي عن المنكر, ينبغي أن ينظر في حالة المأمور, ويستعمل معه الرفق والسياسة, التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم, ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله, يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه, فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود.
{ وَاتَّقُوا اللَّهَ } هذا هو البر الذي أمر الله به, وهو لزوم تقواه على الدوام, بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه, فإنه سبب للفلاح, الذي هو الفوز بالمطلوب, والنجاة من المرهوب، فمن لم يتق الله تعالى, لم يكن له سبيل إلى الفلاح, ومن اتقاه, فاز بالفلاح والنجاح.
{ 190 - 193 } { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ *
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ }
هذه الآيات, تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله, وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة, لما قوي المسلمون للقتال, أمرهم الله به, بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم، وفي تخصيص القتال { فِي سَبِيلِ اللَّهِ } حث على الإخلاص, ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين.
{ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } أي: الذين هم مستعدون لقتالكم, وهم المكلفون الرجال, غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال.
والنهي عن الاعتداء, يشمل أنواع الاعتداء كلها, من قتل من لا يقاتل, من النساء, والمجانين والأطفال, والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى, وقتل الحيوانات, وقطع الأشجار [ونحوها], لغير مصلحة تعود للمسلمين.
ومن الاعتداء, مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها, فإن ذلك لا يجوز.
{ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ } هذا أمر بقتالهم, أينما وجدوا في كل وقت, وفي كل زمان قتال مدافعة, وقتال مهاجمة ثم استثنى من هذا العموم قتالهم { عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال, فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت, حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا, فإن الله يتوب عليهم, ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله, والشرك في المسجد الحرام, وصد الرسول والمؤمنين عنه وهذا من رحمته وكرمه بعباده.
ولما كان القتال عند المسجد الحرام, يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام, أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك, والصد عن دينه, أشد من مفسدة القتل, فليس عليكم - أيها المسلمون - حرج في قتالهم.
ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي: أنه يرتكب أخف المفسدتين, لدفع أعلاهما.
ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله, وأنه ليس المقصود به, سفك دماء الكفار, وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن { يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ } تعالى, فيظهر دين الله [تعالى], على سائر الأديان, ويدفع كل ما يعارضه, من الشرك وغيره, وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود, فلا قتل ولا قتال، { فَإِنِ انْتَهَوْا } عن قتالكم عند المسجد الحرام { فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ } أي: فليس عليهم منكم اعتداء, إلا من ظلم منهم, فإنه يستحق المعاقبة, بقدر ظلمه.
{ 194 } { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ }
يقول تعالى: { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ } يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية, عن الدخول لمكة, وقاضوهم على دخولها من قابل, وكان الصد والقضاء في شهر حرام, وهو ذو القعدة, فيكون هذا بهذا، فيكون فيه, تطييب لقلوب الصحابة, بتمام نسكهم, وكماله.
ويحتمل أن يكون المعنى: إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه, وهم المعتدون, فليس عليكم في ذلك حرج، وعلى هذا فيكون قوله: { وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } من باب عطف العام على الخاص، أي: كل شيء يحترم من شهر حرام, أو بلد حرام, أو إحرام, أو ما هو أعم من ذلك, جميع ما أمر الشرع باحترامه, فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه، فمن قاتل في الشهر الحرام, قوتل، ومن هتك البلد الحرام, أخذ منه الحد, ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به, ومن جرحه أو قطع عضوا, منه, اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم, أخذ منه بدله، ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء, الراجح من ذلك, أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف, إذا لم يقره غيره, والزوجة, والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة [من الإنفاق عليه] فإنه يجوز أخذه من ماله.
وإن كان السبب خفيا, كمن جحد دين غيره, أو خانه في وديعة, أو سرق منه ونحو ذلك, فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له, جمعا بين الأدلة, ولهذا قال تعالى, تأكيدا وتقوية لما تقدم: { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } هذا تفسير لصفة المقاصة, وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي.
ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي, أمر تعالى بلزوم تقواه, التي هي الوقوف عند حدوده, وعدم تجاوزها, وأخبر تعالى أنه { مَعَ الْمُتَّقِينَ } أي: بالعون, والنصر, والتأييد, والتوفيق.
ومن كان الله معه, حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه, وخذله, فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد.
{ 195 } { وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }
يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله, وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير, من صدقة على مسكين, أو قريب, أو إنفاق على من تجب مؤنته.
وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال, وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة, الإعانة على تقوية المسلمين, وعلى توهية الشرك وأهله, وعلى إقامة دين الله وإعزازه، فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح, لا يمكن وجوده بدونها، وفي ترك الإنفاق في سبيل الله, إبطال للجهاد, وتسليط للأعداء, وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى: { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } كالتعليل لذلك، والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد, إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح, فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك, ترك الجهاد في سبيل الله, أو النفقة فيه, الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف, أو محل مسبعة أو حيات, أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا, أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه, ممن ألقى بيده إلى التهلكة.
ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي الله, واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض, التي في تركها هلاك للروح والدين.
ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان, أمر بالإحسان عموما فقال: { وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان, لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم.
ويدخل فيه الإحسان بالجاه, بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك, الإحسان بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس, من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم, وعيادة مرضاهم, وتشييع جنائزهم, وإرشاد ضالهم, وإعانة من يعمل عملا, والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك, مما هو من الإحسان الذي أمر الله به، ويدخل في الإحسان أيضا, الإحسان في عبادة الله تعالى, وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: " أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه, فإنه يراك "
فمن اتصف بهذه الصفات, كان من الذين قال الله فيهم: { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره.
{ ولما فرغ تعالى من [ذكر] أحكام الصيام فالجهاد, ذكر أحكام الحج فقال: 196 } { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }
يستدل بقوله [تعالى]: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ } على أمور:
أحدها: وجوب الحج والعمرة, وفرضيتهما.
الثاني: وجوب إتمامهما بأركانهما, وواجباتهما, التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: " خذوا عني مناسككم "
الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة.
الرابع: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما, ولو كانا نفلا.
الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهما, وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما.
السادس: وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى.
السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما, إلا بما استثناه الله, وهو الحصر, فلهذا قال: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما, بمرض, أو ضلالة, أو عدو, ونحو ذلك من أنواع الحصر, الذي هو المنع.
{ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي, وهو سبع بدنة, أو سبع بقرة, أو شاة يذبحها المحصر, ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لما صدهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدي, فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل.
ثم قال تعالى: { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } وهذا من محظورات الإحرام, إزالة الشعر, بحلق أو غيره, لأن المعنى واحد من الرأس, أو من البدن, لأن المقصود من ذلك, حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته, وهو موجود في بقية الشعر.
وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر, تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر, حتى يبلغ الهدي محله, وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر, كما تدل عليه الآية.
ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي, لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة, أحرم بالحج, ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك, لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له, والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد, وليس عليه في ذلك من ضرر، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض, ينتفع بحلق رأسه له, أو قروح, أو قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه, ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام, أو صدقة على ستة مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية, فهو مخير، والنسك أفضل, فالصدقة, فالصيام.
ومثل هذا, كل ما كان في معنى ذلك, من تقليم الأظفار, أو تغطية الرأس, أو لبس المخيط, أو الطيب, فإنه يجوز عند الضرورة, مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع, إزالة ما به يترفه.
ثم قال تعالى: { فَإِذَا أَمِنْتُمْ } أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ } بأن توصل بها إليه, وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها.
{ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } أي: فعليه ما تيسر من الهدي, وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك, مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة, ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة, وقبل الشروع في الحج، ومثلها القِران لحصول النسكين له.
ويدل مفهوم الآية, على أن المفرد للحج, ليس عليه هدي، ودلت الآية, على جواز, بل فضيلة المتعة, وعلى جواز فعلها في أشهر الحج.
{ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } أي الهدي أو ثمنه { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ } أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة, وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر, أيام رمي الجمار, والمبيت بـ "منى" ولكن الأفضل منها, أن يصوم السابع, والثامن, والتاسع، { وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } أي: فرغتم من أعمال الحج, فيجوز فعلها في مكة, وفي الطريق, وعند وصوله إلى أهله.
{ ذَلِكَ } المذكور من وجوب الهدي على المتمتع { لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } بأن كان عند مسافة قصر فأكثر, أو بعيدا عنه عرفات, فهذا الذي يجب عليه الهدي, لحصول النسكين له في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام, فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.
{ وَاتَّقُوا اللَّهَ } أي: في جميع أموركم, بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه، ومن ذلك, امتثالكم, لهذه المأمورات, واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية.
{ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } أي: لمن عصاه, وهذا هو الموجب للتقوى, فإن من خاف عقاب الله, انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب, ولم يرج الثواب, اقتحم المحارم, وتجرأ على ترك الواجبات.
{ 197 } { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ }
يخبر تعالى أن { الْحَجَّ } واقع في { أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } عند المخاطبين, مشهورات, بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره, وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس.
وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم, التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم.
والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوال, وذو القعدة, وعشر من ذي الحجة, فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا.
{ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } أي: أحرم به, لأن الشروع فيه يصيره فرضا, ولو كان نفلا.
واستدل بهذه ا
يقول تعالى: { لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ } أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد, فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: " ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " ونحو ذلك.
{ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ } أي: بأنه إله واحد, موصوف بكل صفة كمال, منزه عن كل نقص.
{ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } وهو كل ما أخبر الله به في كتابه, أو أخبر به الرسول, مما يكون بعد الموت.
{ وَالْمَلَائِكَةِ } الذين وصفهم الله لنا في كتابه, ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم { وَالْكِتَابِ } أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على رسوله, وأعظمها القرآن, فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام، { وَالنَّبِيِّينَ } عموما, خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم.
{ وَآتَى الْمَالَ } وهو كل ما يتموله الإنسان من مال, قليلا كان أو كثيرا، أي: أعطى المال { عَلَى حُبِّهِ } أي: حب المال ، بيَّن به أن المال محبوب للنفوس, فلا يكاد يخرجه العبد.
فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى, كان هذا برهانا لإيمانه، ومن إيتاء المال على حبه, أن يتصدق وهو صحيح شحيح, يأمل الغنى, ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة, كانت أفضل, لأنه في هذه الحال, يحب إمساكه, لما يتوهمه من العدم والفقر.
وكذلك إخراج النفيس من المال, وما يحبه من ماله كما قال تعالى: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه.
ثم ذكر المنفق عليهم, وهم أولى الناس ببرك وإحسانك. من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم, وتفرح بسرورهم, الذين يتناصرون ويتعاقلون، فمن أحسن البر وأوفقه, تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي, على حسب قربهم وحاجتهم.
ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم, وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته [تعالى] بالعباد, الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده، فالله قد أوصى العباد, وفرض عليهم في أموالهم, الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيم غيره, رُحِمَ يتيمه.
{ وَالْمَسَاكِين } وهم الذين أسكنتهم الحاجة, وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء, بما يدفع مسكنتهم أو يخففها, بما يقدرون عليه, وبما يتيسر، { وَابْنَ السَّبِيلِ } وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال, ما يعينه على سفره, لكونه مظنة الحاجة, وكثرة المصارف، فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته, وخوله من نعمته, أن يرحم أخاه الغريب, الذي بهذه الصفة, على حسب استطاعته, ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره, أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها.
{ وَالسَّائِلِينَ } أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج, توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية, أو ضريبة عليه من ولاة الأمور, أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة, كالمساجد, والمدارس, والقناطر, ونحو ذلك, فهذا له حق وإن كان غنيا { وَفِي الرِّقَابِ } فيدخل فيه العتق والإعانة عليه, وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده, وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة.
{ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ } قد تقدم مرارا, أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة, لكونهما أفضل العبادات, وأكمل القربات, عبادات قلبية, وبدنية, ومالية, وبهما يوزن الإيمان, ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان.
{ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا } والعهد: هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه. فدخل في ذلك حقوق الله كلها, لكون الله ألزم بها عباده والتزموها, ودخلوا تحت عهدتها, ووجب عليهم أداؤها, وحقوق العباد, التي أوجبها الله عليهم, والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور, ونحو ذلك.
{ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ } أي: الفقر, لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة, لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره.
فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم، وإن عرى أو كاد تألم, وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم, وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم.
فكل هذه ونحوها, مصائب, يؤمر بالصبر عليها, والاحتساب, ورجاء الثواب من الله عليها.
{ وَالضَّرَّاءِ } أي: المرض على اختلاف أنواعه, من حمى, وقروح, ورياح, ووجع عضو, حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك, فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك؛ لأن النفس تضعف, والبدن يألم, وذلك في غاية المشقة على النفوس, خصوصا مع تطاول ذلك, فإنه يؤمر بالصبر, احتسابا لثواب الله [تعالى].
{ وَحِينَ الْبَأْسِ } أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم, لأن الجلاد, يشق غاية المشقة على النفس, ويجزع الإنسان من القتل, أو الجراح أو الأسر, فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا, ورجاء لثواب الله [تعالى] الذي منه النصر والمعونة, التي وعدها الصابرين.
{ أُولَئِكَ } أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة, والأعمال التي هي آثار الإيمان, وبرهانه ونوره, والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية، فأولئك هم { الَّذِينَ صَدَقُوا } في إيمانهم, لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، { وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ } لأنهم تركوا المحظور, وفعلوا المأمور؛ لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير, تضمنا ولزوما, لأن الوفاء بالعهد, يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها, كان بما سواها أقوم, فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون.
وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة, من الثواب الدنيوي والأخروي, مما لا يمكن تفصيله في [مثل] هذا الموضع.
{ 178 - 179 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }
يمتن تعالى على عباده المؤمنين, بأنه فرض عليهم { الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } أي: المساواة فيه, وأن يقتل القاتل على الصفة, التي قتل عليها المقتول, إقامة للعدل والقسط بين العباد.
وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين, فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم، حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول, إذا طلب القصاص وتمكينه من القاتل, وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد, ويمنعوا الولي من الاقتصاص, كما عليه عادة الجاهلية, ومن أشبههم من إيواء المحدثين.
ثم بيَّن تفصيل ذلك فقال: { الْحُرُّ بِالْحُرِّ } يدخل بمنطقوقها, الذكر بالذكر، { وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى } والأنثى بالذكر, والذكر بالأنثى, فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله: " الأنثى بالأنثى " مع دلالة السنة, على أن الذكر يقتل بالأنثى، وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا، فلا يقتلان بالولد, لورود السنة بذلك، مع أن في قوله: { الْقِصَاصُ } ما يدل على أنه ليس من العدل, أن يقتل الوالد بولده، ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة, ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله, أو أذية شديدة جدا من الولد له.
وخرج من العموم أيضا, الكافر بالسنة, مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة.
وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه، والعبد بالعبد, ذكرا كان أو أنثى, تساوت قيمتهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر, لا يقتل بالعبد, لكونه غير مساو له، والأنثى بالأنثى, أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة, وتقدم وجه ذلك.
وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل, وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية, أو عفا بعض الأولياء, فإنه يسقط القصاص, وتجب الدية, وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي.
فإذا عفا عنه وجب على الولي, [أي: ولي المقتول] أن يتبع القاتل { بِالْمَعْرُوفِ } من غير أن يشق عليه, ولا يحمله ما لا يطيق, بل يحسن الاقتضاء والطلب, ولا يحرجه.
وعلى القاتل { أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } من غير مطل ولا نقص, ولا إساءة فعلية أو قولية, فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو, إلا الإحسان بحسن القضاء، وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق, بالأداء بإحسان
وفي قوله: { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ } ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا.
وفي قوله: { أَخِيهِ } دليل على أن القاتل لا يكفر, لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان, فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر, لا يكفر بها فاعلها, وإنما ينقص بذلك إيمانه.
وإذا عفا أولياء المقتول, أو عفا بعضهم, احتقن دم القاتل, وصار معصوما منهم ومن غيرهم, ولهذا قال: { فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ } أي: بعد العفو { فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } أي: في الآخرة، وأما قتله وعدمه, فيؤخذ مما تقدم, لأنه قتل مكافئا له, فيجب قتله بذلك.
وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل, فإن الآية تدل على أنه يتعين قتله, ولا يجوز العفو عنه, وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول, لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.
ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } أي: تنحقن بذلك الدماء, وتنقمع به الأشقياء, لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل, لا يكاد يصدر منه القتل, وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر, فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل, لم يحصل انكفاف الشر, الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية, فيها من النكاية والانزجار, ما يدل على حكمة الحكيم الغفار، ونكَّر " الحياة " لإفادة التعظيم والتكثير.
ولما كان هذا الحكم, لا يعرف حقيقته, إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة, خصهم بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى, يحب من عباده, أن يعملوا أفكارهم وعقولهم, في تدبر ما في أحكامه من الحكم, والمصالح الدالة على كماله, وكمال حكمته وحمده, وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة, فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب, وناداهم رب الأرباب, وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون.
وقوله: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة, أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله, ويعظم معاصيه فيتركها, فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.
{ 180 - 182 } { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }
أي: فرض الله عليكم, يا معشر المؤمنين { إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ } أي: أسبابه, كالمرض المشرف على الهلاك, وحضور أسباب المهالك، وكان قد { تَرَكَ خَيْرًا } [أي: مالا] وهو المال الكثير عرفا, فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف, على قدر حاله من غير سرف, ولا اقتصار على الأبعد, دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة, ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل.
وقوله: { حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } دل على وجوب ذلك, لأن الحق هو: الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى.
واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين, مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة, ردها الله تعالى إلى العرف الجاري.
ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث, بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف, فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة, ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين, لأن كلا من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا, واختلف المورد.
فبهذا الجمع, يحصل الاتفاق, والجمع بين الآيات, لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ, الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية, لما يتوهمه أن من بعده, قد يبدل ما وصى به قال تعالى: { فَمَنْ بَدَّلَهُ } أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم { بَعْدَمَا سَمِعَهُ } [أي:] بعدما عقله, وعرف طرقه وتنفيذه، { فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ } وإلا فالموصي وقع أجره على الله, وإنما الإثم على المبدل المغير.
{ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ } يسمع سائر الأصوات, ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه, وأن لا يجور في وصيته، { عَلِيمٌ } بنيته, وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي, وعلم الله من نيته ذلك, أثابه ولو أخطأ، وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به, مطلع على ما فعله, فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة.
وأما الوصية التي فيها حيف وجنف, وإثم، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها, أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل, وأن ينهاه عن الجور والجنف, وهو: الميل بها عن خطأ, من غير تعمد, والإثم: وهو التعمد لذلك.
فإن لم يفعل ذلك, فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم, ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة, ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم فهذا قد فعل معروفا عظيما, وليس عليهم إثم, كما على مبدل الوصية الجائزة، ولهذا قال: { إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ } أي: يغفر جميع الزلات, ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه, ومنه مغفرته لمن غض من نفسه, وترك بعض حقه لأخيه, لأن من سامح, سامحه الله، غفور لميتهم الجائر في وصيته, إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته، رحيم بعباده, حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون، فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية, وعلى بيان من هي له, وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة, والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة.
{ 183 - 185 } { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }
يخبر تعالى بما منَّ به على عباده, بأنه فرض عليهم الصيام, كما فرضه على الأمم السابقة, لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان.
وفيه تنشيط لهذه الأمة, بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال, والمسارعة إلى صالح الخصال, وأنه ليس من الأمور الثقيلة, التي اختصيتم بها.
ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى, لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه.
فمما اشتمل عليه من التقوى: أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها, التي تميل إليها نفسه, متقربا بذلك إلى الله, راجيا بتركها, ثوابه، فهذا من التقوى.
ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى, فيترك ما تهوى نفسه, مع قدرته عليه, لعلمه باطلاع الله عليه، ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان, فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم, فبالصيام, يضعف نفوذه, وتقل منه المعاصي، ومنها: أن الصائم في الغالب, تكثر طاعته, والطاعات من خصال التقوى، ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم الجوع, أوجب له ذلك, مواساة الفقراء المعدمين, وهذا من خصال التقوى.
ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام, أخبر أنه أيام معدودات, أي: قليلة في غاية السهولة.
ثم سهل تسهيلا آخر. فقال: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وذلك للمشقة, في الغالب, رخص الله لهما, في الفطر.
ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن, أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض, وانقضى السفر, وحصلت الراحة.
وفي قوله: { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ } فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان, كاملا كان, أو ناقصا, وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة, عن أيام طويلة حارة كالعكس.
وقوله: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } أي: يطيقون الصيام { فِدْيَةٌ } عن كل يوم يفطرونه { طَعَامُ مِسْكِينٍ } وهذا في ابتداء فرض الصيام, لما كانوا غير معتادين للصيام, وكان فرضه حتما, فيه مشقة عليهم, درجهم الرب الحكيم, بأسهل طريق، وخيَّر المطيق للصوم بين أن يصوم, وهو أفضل, أو يطعم، ولهذا قال: { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ }
ثم بعد ذلك, جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق, يفطر ويقضيه في أيام أخر [وقيل: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } أي: يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة, كالشيخ الكبير, فدية عن كل يوم مسكين وهذا هو الصحيح]
{ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } أي: الصوم المفروض عليكم, هو شهر رمضان, الشهر العظيم, الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم, المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية, وتبيين الحق بأوضح بيان, والفرقان بين الحق والباطل, والهدى والضلال, وأهل السعادة وأهل الشقاوة.
فحقيق بشهر, هذا فضله, وهذا إحسان الله عليكم فيه, أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام.
فلما قرره, وبين فضيلته, وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر.
ولما كان النسخ للتخيير, بين الصيام والفداء خاصة, أعاد الرخصة للمريض والمسافر, لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة [فقال] { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } أي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير, ويسهلها أشد تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله.
وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله, سهَّله تسهيلا آخر, إما بإسقاطه, أو تخفيفه بأنواع التخفيفات.
وهذه جملة لا يمكن تفصيلها, لأن تفاصيلها, جميع الشرعيات, ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات.
{ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ } وهذا - والله أعلم - لئلا يتوهم متوهم, أن صيام رمضان, يحصل المقصود منه ببعضه, دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله [تعالى] عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده, وبالتكبير عند انقضائه, ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد.
{ 186 } { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }
هذا جواب سؤال، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله, أقريب ربنا فنناجيه, أم بعيد فنناديه؟ فنزل: { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ } لأنه تعالى, الرقيب الشهيد, المطلع على السر وأخفى, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, فهو قريب أيضا من داعيه, بالإجابة، ولهذا قال: { أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ } والدعاء نوعان: دعاء عبادة, ودعاء مسألة.
والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه, وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق.
فمن دعا ربه بقلب حاضر, ودعاء مشروع, ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء, كأكل الحرام ونحوه, فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء, وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية, والإيمان به, الموجب للاستجابة، فلهذا قال: { فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة, ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره, سبب لحصول العلم كما قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا
{ 187 } ثم قال تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }
كان في أول فرض الصيام، يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم، فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به.
{ فتاب } الله { عليكم } بأن وسع لكم أمرا كان - لولا توسعته - موجبا للإثم { وعفا عنكم } ما سلف من التخون.
{ فالآن } بعد هذه الرخصة والسعة من الله { باشروهن } وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك.
{ وابتغوا ما كتب الله لكم } أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته، وحصول مقاصد النكاح.
ومما كتب الله لكم ليلة القدر، الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة، وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك.
{ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه.
وفيه: دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد.
وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر، أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق.
{ ثم } إذا طلع الفجر { أتموا الصيام } أي: الإمساك عن المفطرات { إلى الليل } وهو غروب الشمس ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله: { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } أي: وأنتم متصفون بذلك، ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله [تعالى]، وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد.
ويستفاد من تعريف المساجد، أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس.
وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف.
{ تلك } المذكورات - وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطء على المعتكف، ونحو ذلك من المحرمات { حدود الله } التي حدها لعباده، ونهاهم عنها، فقال: { فلا تقربوها } أبلغ من قوله: " فلا تفعلوها " لأن القربان، يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه، والنهي عن وسائله الموصلة إليه.
والعبد مأمور بترك المحرمات، والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها، وأما الأوامر فيقول الله فيها: { تلك حدود الله فلا تعتدوها } فينهى عن مجاوزتها.
{ كذلك } أي: بيَّن [الله] لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين، وأوضحها لهم أكمل إيضاح.
{ يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون } فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه، فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته، لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى.
{ 188 } { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ }
أي: ولا تأخذوا أموالكم أي: أموال غيركم، أضافها إليهم, لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه, ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة.
ولما كان أكلها نوعين: نوعا بحق, ونوعا بباطل, وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل, قيده تعالى بذلك، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية, أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا, أخذها على وجه المعاوضة, بمعاوضة محرمة, كعقود الربا, والقمار كلها, فإنها من أكل المال بالباطل, لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة, ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات, والأوقاف، والوصايا, لمن ليس له حق منها, أو فوق حقه.
فكل هذا ونحوه, من أكل المال بالباطل, فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع, وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة, غلبت حجة المحق, وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم, لا يبيح محرما, ولا يحلل حراما, إنما يحكم على نحو مما يسمع, وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة, ولا شبهة, ولا استراحة.
فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة, وحكم له بذلك, فإنه لا يحل له, ويكون آكلا لمال غيره, بالباطل والإثم, وهو عالم بذلك. فيكون أبلغ في عقوبته, وأشد في نكاله.
وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه, لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: { وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا }
{ 189 } { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }
يقول تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ } جمع - هلال - ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن ذاتها، { قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ } أي: جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول الشهر, ثم يتزايد إلى نصفه, ثم يشرع في النقص إلى كماله, وهكذا, ليعرف الناس بذلك, مواقيت عباداتهم من الصيام, وأوقات الزكاة, والكفارات, وأوقات الحج.
ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات, ويستغرق أوقاتا كثيرة قال: { وَالْحَجِّ } وكذلك تعرف بذلك, أوقات الديون المؤجلات, ومدة الإجارات, ومدة العدد والحمل, وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، فجعله تعالى, حسابا, يعرفه كل أحد, من صغير, وكبير, وعالم, وجاهل، فلو كان الحساب بالسنة الشمسية, لم يعرفه إلا النادر من الناس.
{ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا } وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب, إذا أحرموا, لم يدخلوا البيوت من أبوابها, تعبدا بذلك, وظنا أنه بر. فأخبر الله أنه ليس ببر لأن الله تعالى, لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله, فهو متعبد ببدعة، وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم, التي هي قاعدة من قواعد الشرع.
ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور, أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب, الذي قد جعل له موصلا، فالآمر بالمعروف, والناهي عن المنكر, ينبغي أن ينظر في حالة المأمور, ويستعمل معه الرفق والسياسة, التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم, ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله, يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه, فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود.
{ وَاتَّقُوا اللَّهَ } هذا هو البر الذي أمر الله به, وهو لزوم تقواه على الدوام, بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه, فإنه سبب للفلاح, الذي هو الفوز بالمطلوب, والنجاة من المرهوب، فمن لم يتق الله تعالى, لم يكن له سبيل إلى الفلاح, ومن اتقاه, فاز بالفلاح والنجاح.
{ 190 - 193 } { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ *
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ }
هذه الآيات, تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله, وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة, لما قوي المسلمون للقتال, أمرهم الله به, بعد ما كانوا مأمورين بكف أيديهم، وفي تخصيص القتال { فِي سَبِيلِ اللَّهِ } حث على الإخلاص, ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين.
{ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } أي: الذين هم مستعدون لقتالكم, وهم المكلفون الرجال, غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال.
والنهي عن الاعتداء, يشمل أنواع الاعتداء كلها, من قتل من لا يقاتل, من النساء, والمجانين والأطفال, والرهبان ونحوهم والتمثيل بالقتلى, وقتل الحيوانات, وقطع الأشجار [ونحوها], لغير مصلحة تعود للمسلمين.
ومن الاعتداء, مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها, فإن ذلك لا يجوز.
{ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ } هذا أمر بقتالهم, أينما وجدوا في كل وقت, وفي كل زمان قتال مدافعة, وقتال مهاجمة ثم استثنى من هذا العموم قتالهم { عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال, فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت, حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا, فإن الله يتوب عليهم, ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله, والشرك في المسجد الحرام, وصد الرسول والمؤمنين عنه وهذا من رحمته وكرمه بعباده.
ولما كان القتال عند المسجد الحرام, يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام, أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك, والصد عن دينه, أشد من مفسدة القتل, فليس عليكم - أيها المسلمون - حرج في قتالهم.
ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي: أنه يرتكب أخف المفسدتين, لدفع أعلاهما.
ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله, وأنه ليس المقصود به, سفك دماء الكفار, وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن { يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ } تعالى, فيظهر دين الله [تعالى], على سائر الأديان, ويدفع كل ما يعارضه, من الشرك وغيره, وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود, فلا قتل ولا قتال، { فَإِنِ انْتَهَوْا } عن قتالكم عند المسجد الحرام { فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ } أي: فليس عليهم منكم اعتداء, إلا من ظلم منهم, فإنه يستحق المعاقبة, بقدر ظلمه.
{ 194 } { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ }
يقول تعالى: { الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ } يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية, عن الدخول لمكة, وقاضوهم على دخولها من قابل, وكان الصد والقضاء في شهر حرام, وهو ذو القعدة, فيكون هذا بهذا، فيكون فيه, تطييب لقلوب الصحابة, بتمام نسكهم, وكماله.
ويحتمل أن يكون المعنى: إنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه, وهم المعتدون, فليس عليكم في ذلك حرج، وعلى هذا فيكون قوله: { وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ } من باب عطف العام على الخاص، أي: كل شيء يحترم من شهر حرام, أو بلد حرام, أو إحرام, أو ما هو أعم من ذلك, جميع ما أمر الشرع باحترامه, فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه، فمن قاتل في الشهر الحرام, قوتل، ومن هتك البلد الحرام, أخذ منه الحد, ولم يكن له حرمة، ومن قتل مكافئا له قتل به, ومن جرحه أو قطع عضوا, منه, اقتص منه، ومن أخذ مال غيره المحترم, أخذ منه بدله، ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء, الراجح من ذلك, أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف, إذا لم يقره غيره, والزوجة, والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة [من الإنفاق عليه] فإنه يجوز أخذه من ماله.
وإن كان السبب خفيا, كمن جحد دين غيره, أو خانه في وديعة, أو سرق منه ونحو ذلك, فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له, جمعا بين الأدلة, ولهذا قال تعالى, تأكيدا وتقوية لما تقدم: { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ } هذا تفسير لصفة المقاصة, وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي.
ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي, أمر تعالى بلزوم تقواه, التي هي الوقوف عند حدوده, وعدم تجاوزها, وأخبر تعالى أنه { مَعَ الْمُتَّقِينَ } أي: بالعون, والنصر, والتأييد, والتوفيق.
ومن كان الله معه, حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه, وخذله, فوكله إلى نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد.
{ 195 } { وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ }
يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله, وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهي كل طرق الخير, من صدقة على مسكين, أو قريب, أو إنفاق على من تجب مؤنته.
وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال, وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة, الإعانة على تقوية المسلمين, وعلى توهية الشرك وأهله, وعلى إقامة دين الله وإعزازه، فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح, لا يمكن وجوده بدونها، وفي ترك الإنفاق في سبيل الله, إبطال للجهاد, وتسليط للأعداء, وشدة تكالبهم، فيكون قوله تعالى: { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } كالتعليل لذلك، والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد, إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح, فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك, ترك الجهاد في سبيل الله, أو النفقة فيه, الموجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف, أو محل مسبعة أو حيات, أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا, أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، فهذا ونحوه, ممن ألقى بيده إلى التهلكة.
ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة الإقامة على معاصي الله, واليأس من التوبة، ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض, التي في تركها هلاك للروح والدين.
ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان, أمر بالإحسان عموما فقال: { وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان, لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم.
ويدخل فيه الإحسان بالجاه, بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك, الإحسان بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, وتعليم العلم النافع، ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس, من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم, وعيادة مرضاهم, وتشييع جنائزهم, وإرشاد ضالهم, وإعانة من يعمل عملا, والعمل لمن لا يحسن العمل ونحو ذلك, مما هو من الإحسان الذي أمر الله به، ويدخل في الإحسان أيضا, الإحسان في عبادة الله تعالى, وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: " أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه, فإنه يراك "
فمن اتصف بهذه الصفات, كان من الذين قال الله فيهم: { لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ } وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره.
{ ولما فرغ تعالى من [ذكر] أحكام الصيام فالجهاد, ذكر أحكام الحج فقال: 196 } { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }
يستدل بقوله [تعالى]: { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ } على أمور:
أحدها: وجوب الحج والعمرة, وفرضيتهما.
الثاني: وجوب إتمامهما بأركانهما, وواجباتهما, التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: " خذوا عني مناسككم "
الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة.
الرابع: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما, ولو كانا نفلا.
الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهما, وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما.
السادس: وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى.
السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما, إلا بما استثناه الله, وهو الحصر, فلهذا قال: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } أي: منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما, بمرض, أو ضلالة, أو عدو, ونحو ذلك من أنواع الحصر, الذي هو المنع.
{ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي, وهو سبع بدنة, أو سبع بقرة, أو شاة يذبحها المحصر, ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لما صدهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدي, فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل.
ثم قال تعالى: { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } وهذا من محظورات الإحرام, إزالة الشعر, بحلق أو غيره, لأن المعنى واحد من الرأس, أو من البدن, لأن المقصود من ذلك, حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته, وهو موجود في بقية الشعر.
وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر, تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر, حتى يبلغ الهدي محله, وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر, كما تدل عليه الآية.
ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي, لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة, أحرم بالحج, ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك, لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له, والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد, وليس عليه في ذلك من ضرر، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض, ينتفع بحلق رأسه له, أو قروح, أو قمل ونحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه, ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام, أو صدقة على ستة مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية, فهو مخير، والنسك أفضل, فالصدقة, فالصيام.
ومثل هذا, كل ما كان في معنى ذلك, من تقليم الأظفار, أو تغطية الرأس, أو لبس المخيط, أو الطيب, فإنه يجوز عند الضرورة, مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع, إزالة ما به يترفه.
ثم قال تعالى: { فَإِذَا أَمِنْتُمْ } أي: بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره، { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ } بأن توصل بها إليه, وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها.
{ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } أي: فعليه ما تيسر من الهدي, وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك, مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة, ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة, وقبل الشروع في الحج، ومثلها القِران لحصول النسكين له.
ويدل مفهوم الآية, على أن المفرد للحج, ليس عليه هدي، ودلت الآية, على جواز, بل فضيلة المتعة, وعلى جواز فعلها في أشهر الحج.
{ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } أي الهدي أو ثمنه { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ } أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة, وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر, أيام رمي الجمار, والمبيت بـ "منى" ولكن الأفضل منها, أن يصوم السابع, والثامن, والتاسع، { وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } أي: فرغتم من أعمال الحج, فيجوز فعلها في مكة, وفي الطريق, وعند وصوله إلى أهله.
{ ذَلِكَ } المذكور من وجوب الهدي على المتمتع { لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } بأن كان عند مسافة قصر فأكثر, أو بعيدا عنه عرفات, فهذا الذي يجب عليه الهدي, لحصول النسكين له في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام, فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك.
{ وَاتَّقُوا اللَّهَ } أي: في جميع أموركم, بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه، ومن ذلك, امتثالكم, لهذه المأمورات, واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية.
{ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } أي: لمن عصاه, وهذا هو الموجب للتقوى, فإن من خاف عقاب الله, انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب، وأما من لم يخف العقاب, ولم يرج الثواب, اقتحم المحارم, وتجرأ على ترك الواجبات.
{ 197 } { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ }
يخبر تعالى أن { الْحَجَّ } واقع في { أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } عند المخاطبين, مشهورات, بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره, وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس.
وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم, التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم.
والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوال, وذو القعدة, وعشر من ذي الحجة, فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا.
{ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } أي: أحرم به, لأن الشروع فيه يصيره فرضا, ولو كان نفلا.
واستدل بهذه ا
 مواضيع مماثلة
مواضيع مماثلة» - تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 26-57 ) وهي مدنية
» - تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 58-78 ) وهي مدنية
» - تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 79-100 ) وهي مدنية
» تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 101-125 ) وهي مدنية
» تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 126-150 ) وهي مدنية
» - تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 58-78 ) وهي مدنية
» - تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 79-100 ) وهي مدنية
» تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 101-125 ) وهي مدنية
» تفسير سورة البقرة عدد آياتها 286 ( آية 126-150 ) وهي مدنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى